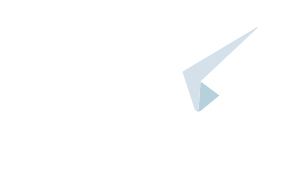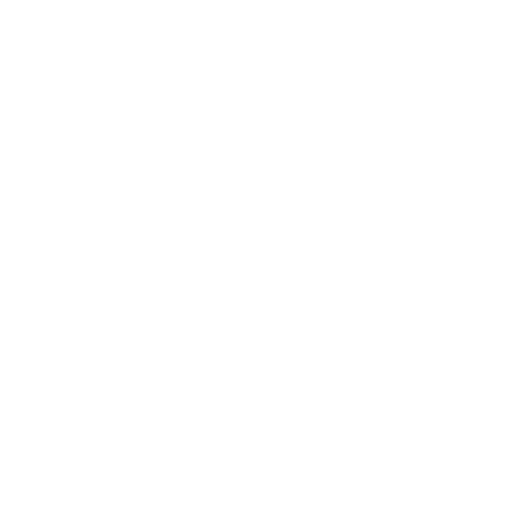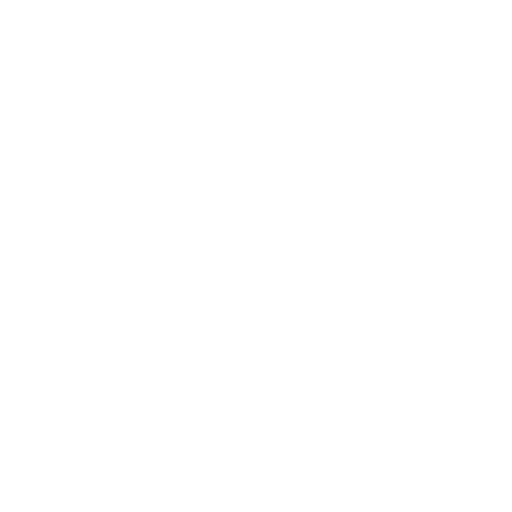التاريخ والحضارة

التاريخ

الحضارة

ابرز المؤرخين


اقوام وادي الرافدين

السومريون

الساميون

اقوام مجهولة


العصور الحجرية

عصر ماقبل التاريخ

العصور الحجرية في العراق

العصور القديمة في مصر

العصور القديمة في الشام

العصور القديمة في العالم

العصر الشبيه بالكتابي

العصر الحجري المعدني

العصر البابلي القديم

عصر فجر السلالات


الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

الاراميون

الاشوريون

الاكديون

بابل

لكش

سلالة اور


العهود الاجنبية القديمة في العراق

الاخمينيون

المقدونيون

السلوقيون

الفرثيون

الساسانيون


احوال العرب قبل الاسلام

عرب قبل الاسلام

ايام العرب قبل الاسلام


مدن عربية قديمة

الحضر

الحميريون

الغساسنة

المعينيون

المناذرة

اليمن

بطرا والانباط

تدمر

حضرموت

سبأ

قتبان

كندة

مكة


التاريخ الاسلامي


السيرة النبوية

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الاسلام

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام


الخلفاء الاربعة

ابو بكر بن ابي قحافة

عمربن الخطاب

عثمان بن عفان


علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

الامام علي (عليه السلام)

اصحاب الامام علي (عليه السلام)


الدولة الاموية

الدولة الاموية *


الدولة الاموية في الشام

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

معاوية بن يزيد بن ابي سفيان

مروان بن الحكم

عبد الملك بن مروان

الوليد بن عبد الملك

سليمان بن عبد الملك

عمر بن عبد العزيز

يزيد بن عبد الملك بن مروان

هشام بن عبد الملك

الوليد بن يزيد بن عبد الملك

يزيد بن الوليد بن عبد الملك

ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

مروان بن محمد


الدولة الاموية في الاندلس

احوال الاندلس في الدولة الاموية

امراء الاندلس في الدولة الاموية


الدولة العباسية

الدولة العباسية *


خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

ابو العباس السفاح

ابو جعفر المنصور

المهدي

الهادي

هارون الرشيد

الامين

المأمون

المعتصم

الواثق

المتوكل


خلفاء بني العباس المرحلة الثانية


عصر سيطرة العسكريين الترك

المنتصر بالله

المستعين بالله

المعتزبالله

المهتدي بالله

المعتمد بالله

المعتضد بالله

المكتفي بالله

المقتدر بالله

القاهر بالله

الراضي بالله

المتقي بالله

المستكفي بالله


عصر السيطرة البويهية العسكرية

المطيع لله

الطائع لله

القادر بالله

القائم بامرالله


عصر سيطرة السلاجقة

المقتدي بالله

المستظهر بالله

المسترشد بالله

الراشد بالله

المقتفي لامر الله

المستنجد بالله

المستضيء بامر الله

الناصر لدين الله

الظاهر لدين الله

المستنصر بامر الله

المستعصم بالله

تاريخ اهل البيت (الاثنى عشر) عليهم السلام

شخصيات تاريخية مهمة

تاريخ الأندلس

طرف ونوادر تاريخية


التاريخ الحديث والمعاصر


التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

تاريخ العراق أثناء الأحتلال المغولي

تاريخ العراق اثناء الاحتلال العثماني الاول و الثاني

تاريخ الاحتلال الصفوي للعراق

تاريخ العراق اثناء الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الاولى

العهد الملكي للعراق

الحرب العالمية الثانية وعودة الاحتلال البريطاني للعراق

قيام الجهورية العراقية

الاحتلال المغولي للبلاد العربية

الاحتلال العثماني للوطن العربي

الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد العربية

الثورة الصناعية في اوربا


تاريخ الحضارة الأوربية

التاريخ الأوربي القديم و الوسيط

التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر
اليهود في مصر في العهد البطلمي 323–300ق.م
المؤلف:
سليم حسن
المصدر:
موسوعة مصر القديمة
الجزء والصفحة:
ج14 ص 663 ــ 674
2025-09-01
86
تحدثنا في الأجزاء السابقة من هذه الموسوعة عن بداية ظهور الإسرائيليين واليهود في مصر، ولكن تدل النقوش الأثرية على أن قوم «عبرو» وهم العبرانيون فيما بعد كانوا يسكنون سوريا وفلسطين منذ عهد البرونز المتأخر، وقد جاء ذكرهم للمرة الأولى على ما نعلم في عهد «أمنحوتب الثاني»، ثم جاء ذكرهم بعد ذلك في خطابات «تل العمارنة»، وتدل شواهد الأحوال على أن أول اتصال أكيد بين الشعبين المصري والإسرائيلي كان في عهد يوسف أي حوالي عام 1700ق.م، وقد تحدثنا عن قصة خروجهم من مصر وشرحناها شرحًا وافيًا في الجزء السابع من مصر القديمة أيضًا.
أما عن قصة هجرة اليهود من فلسطين إلى مصر في العهد المتأخر فيمكن فحصها ودرسها منذ أول القرن السادس ق.م وما بعده، ومن الجائز أن الكارثة التي حلت بهؤلاء القوم في عهد الملك «نبوخذ نصر» عام 596ق.م ترجع إلى غزو هذا العاهل بلادهم وتخريب «أورشليم»، وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في غير هذا المكان، وقد تحدث النبي «أرميا» عن أول موجة من اليهود الذين هاجروا إلى مصر، كما ذكرها «أريستاس» في كتابه المسمى «رسالة أريستاس» Letters Of Aristeas هذا فضلًا عما جاء في الأوراق البردية التي عُثِر عليها في الفنتين.
أما في العهد الهيلانستيكي فمن المحتمل أن هجرة اليهود إلى مصر قد بدأت في عهد «الإسكندر الأكبر»، ومع ذلك فإن البراهين الهزيلة التي قدمها لنا «جوزيفس» تدعو إلى الريبة ويرجع السبب في ذلك إلى أنها مشربة — كما يظهر بداهة — بروح الميل إلى إطراء اليهود والتمدح بأعمالهم، ومن أجل ذلك فإنه قد يكون من الأسلم من الوجهة التاريخية أن نتركها جانبًا.
وتحدثنا المصادر التي وصلت إلينا من عهد «بطليموس الأول سوتر» عن مجيء اليهود إلى مصر، فنعلم أن «بطليموس الأول» فتح فلسطين للمرة الأولى في عام 320ق.م ثم فتحها ثانية في عام 312ق.م وفي عام 302ق.م وأخيرًا فتحها نهائيًّا في عام 301ق.م، وعلى ذلك لن يكون من المدهش أنه في خلال تلك الغزوات العدة قد سيق إلى مصر أسرى كثيرون من اليهود، كما حدثَنَا بذلك «أريستاس»، وقد ظلت فلسطين لمدة قرن من الزمان بعد آخر غزوة في يد مصر (301–198 ق.م) وأعقب فتح فلسطين اتصالات عدة بينها وبين مصر، وتقدم لنا أوراق «زينون» التي لا يمكن تقدير أهميتها التاريخية لدرس بلاد سوريا البطلمية صورة حية عن العلاقات التجارية بين مصر وفلسطين، وكانت من أهم سلع التجارة المتبادلة بينهما تجارة الرقيق، ومن الحقائق التي لا تقل أهمية عما سبق اشتراك أهالي سوريا في الحاميات التي أسسها البطالمة عند النقط الاستراتيجية في جنوب سوريا، وكذلك استعمالهم في أعمال مختلفة لها اتصال بوجود عدد عظيم من الموظفين المصريين في مصر من تجار وقواد حربيين، ومن ثم نجد أنه قد وُجِدَت علاقات سياسية واقتصادية بين السوريين وأسيادهم الجدد، ويمكن أن نفرض قيام هجرة كبيرة من «سوريا» إلى مصر نتيجة لذلك.
وفي عام 198ق.م فتح الملك «أنتيوكوس الثالث» فلسطين، ومنذ هذا العام قضى على كل وحدة إدارية بين جنوب سوريا ومصر، ومن المرجَّح كذلك أن كل علاقة تجارية قد انقطعت أو على أية حال أُوقفت مؤقتًا، ومع ذلك فإن هجرة اليهود من بلادهم لم تتوقف، بل على العكس نجد أنه بعد وقت قصير استمرت بنشاط مجدد، ويرجع السبب في هذا التيار الإضافي من المهاجرين من فلسطين إلى الموقف السياسي الجديد في «يهودا» وهو الذي خلقته الثورة التي قام بها «جوداس ماكابايوس»،8 وتأسيس دولة الهسمونيين اليهودية، وقد غادرت فلسطين عناصر مختلفة بسبب هذه الثورة القومية وبحثوا عن بلاد جديدة يمكنهم أن يسكنوا فيها في سلام ويبدؤون حياة جديدة، وكان بعض هؤلاء المنفيين رجالًا من أصل شريف؛ مثال ذلك «أونياس» الرابع بن «أونياس الثالث» الكاهن الأعظم في فلسطين، وأسرة «أونياس» هذه كانت قد احتلت مركز الكاهن الأول بالوراثة لمدة طويلة ثم نُحيت عن هذه الوظيفة العالية باليهود الذين كانوا يميلون إلى الهيلانية.
فقد قُتل «أونياس الثالث» ومن المحتمل أن ابنه عندما خاف أن يصيبه ما أصاب والده فر إلى مصر، والظاهر أنه لم يصل إلى أرض الكنانة وحده على حسب قول «جيروم» بل صاحَبَتْه «أسراب لا تحصى من اليهود»، وإذا أخذنا في الاعتبار الميل العادي عند المؤلفين القدامى إلى المبالغة في الأرقام، فإنه يمكننا من هذه العبارة القول بأن عدد المهاجرين الجدد كان بلا نزاع كبيرًا، والدور الهام الذي لعبه «أونياس» في مصر كما سنرى بعد ينبئ كذلك أنه كان بصحبته جماعة من الأتباع لمعاضدته وشد أزره، هذا ولدينا رسالة من قنصل روماني (143–139ق.م) موجهة إلى بطليموس الثامن «أيرجيتيس الثاني» يذكر فيه من بين مسائل أخرى أن يسلم للكاهن الأكبر «سيمون» مجرمين سياسيين كانوا قد فروا إلى مصر، وفي هذا الحادث برهان عن مهاجرين سياسيين كانوا في هذه المرة هاربين من اضطهادات الهسمونيين في فلسطين نفسها، هذا وقد حفظ لنا التلمود كذلك قصة عن أحد قادة الفارسيين Pharisee (وهي طائفة من اليهود يميز أتباعها أنفسهم بالصلاح الظاهري في حياتهم غير أنهم في الخفاء غاية في الخلاعة) الذين هربوا إلى مصر من اضطهاد ملك «الصدوقيين» الذين كانوا أعداءهم الألداء، وهذه الطائفة الأخيرة تسير على حسب التفسير الحرفي للقانون الموسوي، وليس لدينا برهان عن هجرة اليهود في خلال المائة السنة الأخيرة من الحكم البطلمي، غير أنه يمكننا أن نفرض أن هذه الهجرة قد استمرت على نفس المقياس السابق، وذلك لأن الحياة السياسية والاقتصادية في القرن الأول ق.م في فلسطين كانت تتدهور بسرعة، وقد قدمت مصر التي كانت تعد أغنى مملكة متاخمة لفلسطين فرصًا عدة لوافدين جدد، ومن ثم جذبت إليها سكان فلسطين.
وكانت مهاجر اليهود مبعثرة في كل أنحاء البلاد المصرية وقد جذبتهم إليها أولًا الإسكندرية، وليس ثمة سبيل إلى تحديد تاريخ وصولهم إلى هذا البلد بدقة، حقًّا يؤكد المؤرخ «جوزيفس» أن «الإسكندر الأكبر» نفسه هو الذي أسكن اليهود في الإسكندرية، غير أنه لا بد أن يأخذ الإنسان مرة أخرى حذره مما ذكره «جوزيفس»، وذلك لأن أول برهان حقيقي عن وجود اليهود في الإسكندرية قد قدمته لنا نقوش إغريقية وآرامية من جبانة «الإبراهيمية» في ضواحي المدينة، ومن المحتمل أنها من عهد «بطليموس الأول» أو الثاني، وقد أخذ عدد السكان اليهود في المدينة يزداد باضطراد حتى إنه في أول العهد الروماني كان هناك حيان من خمسة أحياء في المدينة يسكنها يهود، وقد ثبت وجود اليهود في أماكن مختلفة في الوجه البحري من نقوش تدل على ذلك، ويمكن أن نضيف هنا بعض أماكن أخرى كان يسكنها اليهود من عهد مبكر قبل العهد الهيلانستيكي مثل «المجدل» و«دفنى»، هذا ونعلم أن مستعمرة حربية يهودية قد أقامها «أونياس الرابع» في «ليونتوبوليس» (تل المقدام الحالية بمركز ميت غمر). وتدل النقوش على أن هذه المستعمرة كانت لا تزال قائمة حتى بداية العهد الروماني في مصر، ولدينا أوراق بردية عدة من منتصف القرن الثالث ق.م وما بعده، تدل على وجود سكان يهود في قرى مختلفة ومدن صغيرة في الفيوم، ويثبت ما جاء على الاستراكا عن وجود يهود في الوجه القبلي وبخاصة في «طيبة» في خلال القرن الثاني ق.م، والخلاصة أنه في خلال العهد البطلمي أسس اليهود بيوتهم في كل أنحاء مصر قاطبة من البحر الأبيض شمالًا حتى الفنتين جنوبًا أو كما قال المؤرخ فيلو (Flacc. 43) من منحدر لوبيا حتى حدود «أثيوبيا».
وليس في الإمكان تحديد عدد اليهود الذين كانوا يسكنون مصر؛ فقد تحدث «أريستاس» (Arist. 12–14) عن مائة ألف يهودي أُحضروا من فلسطين إلى مصر أسرى حرب في عهد «بطليموس الأول»، أما «فيلو» (Flacc. 43) فيذكر رقم مليون لليهود الذين يسكنون مصر في عهده، ولا نزاع في أن الرقم الأول مبالغ فيه جدًّا، وذلك لأن سكان «يهودا» من اليهود في نهاية القرن الرابع لم يكونوا من الكثافة بحيث إن مائة ألف نسمة منهم يهاجرون منها دون أن يؤثر ذلك في حياة البلاد تأثيرًا خطيرًا، وفي مثل هذه الحالة كان من المنتظر أن نجد آثارًا في المصادر التي في أيدينا تشبه رد الفعل الذي حدث عند طرد اليهود ونفيهم إلى «بابل» في عام 586ق.م كما أشرنا إلى ذلك من قبل، أما عن الرقم الذي ذكره «فيلو» فليس من سبيل إلى تحقيقه، غير أنه ليس من المرجح أن اليهود كانوا يؤلفون تقريبًا سُبع سكان كل مصر وقتئذ، ولا بد أن نذكر هنا أنه لم يُعمل إحصاء خاص لليهود حتى عام 71-72 بعد الميلاد، وذلك عندما أُدخل نظام الضرائب على اليهود في العهد الروماني، ومن ثم لم يكن في مقدور «فيلو» أن يحصل على رقم صحيح لعدد اليهود في مصر، ولا شك أن قصد «فيلو» من ذكر هذا الرقم الضخم التأثير على قرائه بمثل هذا العدد، وعلى ذلك إذا نظرنا إليه من الوجهة التاريخية فلا بد أن نكون على حذر، وهذه الملاحظة تنطبق كذلك على الأرقام التي أُعطيت عن عدد سكان الإسكندرية من اليهود؛ إذ ليس لدينا برهان كافٍ لإثبات أن عدد اليهود في الإسكندرية يؤلف خُمس سكانها، وذلك لأنهم كانوا يسكنون في حيين من أحيائها الخمسة؛ إذ الواقع أنه ليس لدينا معلومات ذات وزن عن هذه النقطة على ما يظهر.
والهجرة اليهودية إلى مصر كانت جزءًا كبيرًا من هجرة السوريين، وذلك أنه توجد قرى سورية عديدة منتشرة في كل البلاد المصرية كما كانت توجد قرى تحمل أسماء سامية تدل على تعداد السوريين في مصر في خلال العهد البطلمي، هذا وتكثر أسماء الأعلام السورية أي الآرامية في الأوراق البردية، كما ثبت وجود عبادات لآلهة سورية في القرنين الثالث والثاني ق.م.
وكان السوريون في مصر يشتغلون في أنواع مختلفة من التجارة كما كانوا ينتسبون لكل طبقات المجتمع المصري؛ فقد جاء ذكر الكثير من التجار والموظفين والفلاحين الكادحين والعبيد إلخ في أوراق البردي، وعلى الرغم من أنهم يختلفون عن اليهود في دينهم إلا أنهم كانوا يتكلمون لغة مشتركة، ومن المحتمل أنهم كانوا يشبهونهم في المنظر، ولا بد أن نضيف أن فلسطين في خلال القرن الثالث لم تكن تؤلف بمفردها وحدة إدارية خاصة، وأن المديريات الواقعة جنوبي سوريا وهي فينيقيا وفلسطين وشرقي الأردن كانت تسمى رسميًّا «سوريا وفينيقيا»، كما كانت تُدعى بصفة غير رسمية «سوريا» وحسب، ولا غرابة إذا كان السكان المصريون قد خلطوا كل الأقوام الوافدين من سوريا وسموهم كلهم «سوريين»، هذا ونجد أن اللغة العبرية كانت أحيانًا تؤخذ خطأ على أنها اللغة السورية؛ أي الآرامية.
ولما لم تكن لدينا وسيلة للتمييز بين اليهود والسوريين في الوثائق التي في أيدينا، فإنه لا جدوى في السعي إلى تحديد القوة العددية لليهود المصريين من المصادر المأخوذة عن الوثائق التي في متناولنا اللهم إلا إذا كانت هناك دلائل قوية تدل على أصلها الوطني.
وكان اليهود في مصر كإخوانهم في كل مكان في مهجرهم يعيشون في مجتمعات أي في منظمات منفصلة نصف سياسية، لهم قوانينهم وعاداتهم ومبانيهم ومؤسساتهم وقادتهم وموظفوهم، هذا إلى أنهم لم يكونوا مجبرين على أن يعيشوا في «مجتمع» ولكن بطبيعة الحال كان بعضهم مرتبطًا بالبعض الآخر، وكان كل مهاجر قد اضطُر إلى بناء موطن جديد بعيد عن مسقط رأسه يرغب في أن ينشئ حوله جوًّا يشبه جو وطنه الأصلي، وحتى في أيامنا نجد أن المدن الكبيرة المختلطة السكان قسمت أحياء يسكنها كلها أو معظمها أفراد من قومية واحدة، ونجد نفس هذه الصورة في مصر القديمة؛ فتوجد أمثلة كثيرة في الأوراق البردية تدل على أحياء قومية منفصلة في كثير من المدن المصرية، وفي «أرسنوي» كانت هناك أحياء يسكنها كليكيون ومقدونيون وبيتيون وليكيون وعرب وتراقيون وسوريون كلٌّ على حدة.
وعلى ذلك فلا يدهشنا أن اليهود كانوا كذلك يتبعون هذه الطريقة المشتركة نفسها وفضلوا السكن سويًّا، وعلى الرغم من أن الأحياء اليهودية قد سُجلت في العهد الروماني فليس ثمة شك في أن هذه الأحياء كانت موجودة في العهد البطلمي أيضًا، ومع ذلك فإنه لم تكن توجد مساكن يهودية في مصر خاصة باليهود وحسب، والواقع أن اليهود لم يكونوا منحصرين في أحيائهم، ويؤكد «فيلو» بوضوح أن في الإسكندرية قد سكن يهود كثيرون بعيدون عن أحيائهم، وأن المعابد اليهودية كانت منتشرة في كل أنحاء المدينة، ومما يجب ذكره هنا كذلك أن «المجتمع اليهودي» ليس مرادفًا للحي اليهودي؛ فالمجتمع اليهودي كان عبارة عن وحدة قضائية، ولكن لم يكن من الضروري أنها كانت مرتبطة بمساحة معينة من الأرض؛ فقد يكون من الممكن وجود عدة مجتمعات في بلدة واحدة (كما كانت الحال في روما)، ومن جهة أخرى كان من الممكن أن يتحد سكان عدد من الأماكن في مجتمع واحد، وكذلك كان من المستطاع أن يهودًا من بلدة قاطنيين مؤقتًا أو باستمرار في بلدة أخرى يبنون مجتمعًا خاصًّا بهم، كما يحتمل أنه حدث مع يهود من إقليم طيبة قد سكنوا في العهد الروماني في «أرسنوي»، أما من حيث القواعد القانونية الخاصة بالمجتمعات اليهودية في مصر فلم تكن هناك حاجة ماسة لأن تسن الحكومة البطلمية موادَّ جديدة للتشريع، وذلك لأنه كانت توجد جماعات أخرى وطنية لها مكانة قانونية مماثلة.
وكان العالم الهيلانستيكي معتادًا على نظام مؤسسة سياسية تدعى «بوليتوما» Politeuma، وهذا التعبير له معانٍ عدة، ولكن المعنى الأكثر استعمالًا كان «المجتمع السلالي» الذي أتى من الخارج وكان يتمتع بحقوق معينة وله مسكنه في داخل المدينة أو المملكة التي يقطن فيها، ولدينا عدة أمثلة من «البوليتوما» من جماعات وطنية منوعة في مصر.
ولم يشذ اليهود عن هذه القاعدة، ويسمى المجتمع اليهودي في الإسكندرية في رسالة أريستاس بوليتوما، وكذلك كان يسمى في برنيكي من أعمال «سيريني»، وهكذا نجد أنه لم يكن هناك فرق من حيث المبدأ بين مجتمع يهودي و«بوليتوما» من الأدوميين أو الليكيين، ومن ثم نجد أن قوم اليهود كانوا موضوعين بصورة ممتازة في إطار القانون السياسي الهيلانستيكي، وبطبيعة الحال لم يُمنح اليهود حكمًا ذاتيًّا سياسيًّا كاملًا، والواقع أنه في حكم ملك مستبد كانت مسألة الحرية السياسية ليس لها مكان، وحتى المدن الإغريقية في مصر البطلمية لم تكن لها حكومات حرة بالمعنى الحديث بل كانت هناك «مدن» أي مجتمعات يتمتعون بحكم ذاتي، ولهذا السبب لم يكن في مقدور السكان اليهود كلهم في مصر أن يتَّحدوا في نظام قومي واحد، على أن وحدة قومية بمثل هذا الحجم كانت كبيرة على تأليف «بوليتوما»، ومن ثم تكون خطرًا على الدولة، ومن الجائز جدًّا أنه كان هناك اتصال مستمر بين المجتمعات اليهودية وأن المجتمع اليهودي الإسكندري كان له تأثير عظيم على المجتمعات الأخرى، غير أنه مما لا يمكن التسليم به تمامًا السماح لهم بأن يعقدوا اجتماعات منظمة ويتناقشوا في مصالحهم المشتركة بصفة رسمية.
وكان الملك البطلمي مصدر القانون في البلاد كما كان الفرعون من قبله، ومن ثم فإن كل قانون آخر غير الذي سنَّه بطليموس مثل قانون المدن الإغريقية أو قانون السكان المهاجرين الإغريق في البلاد أو حتى القانون القديم للسكان الأصليين كان لا يمكن الاعتراف به إلا بإرادة الملك وتصريح منه، وبدهي أن اليهود لم يشذوا عن هذه القاعدة فكان عليهم أن يتسلموا تصريحًا من الملك لتأليف مجتمع لهم يمكنهم أن يتمتعوا فيه بحقوق معلومة، ولكن مما يؤسف له أنه لم تُحفظ لنا مثل هذه الامتيازات، على أن وجودها كان ممكنًا، ويُستخلص ذلك من قصة قصها «هيكاتايوس» Hekataesus ونقلها عنه «جوزيفس»، ويمكن أن نخمن بسهولة الحق الأساسي الذي منحه الملك المجتمعات اليهودية، ولا شك أنه كان حق المعيشة على حسب قانون الأجداد، وهذه الصيغة مع خلاف قليل تكررت باستمرار في المنشورات الرومانية التي كانت تصدر في صالح اليهود، وكان قد استعملها كذلك الملك «أنتيوكوس الثالث» ملك سوريا في مناسبة فتحه «أورشليم» في عام 198ق.م.
وقد استعمل الصيغة نفسها غالبًا الرومان عند الإشارة إلى المدن المستقلة في الشرق في نهاية الجمهورية الرومانية وبداية حكم «أغسطس».
ولما كان الرومان قد أخذوا عادة المؤسسات القانونية للممالك المفتوحة دون إجراء أي تغيير أساسي، فإنه من المستطاع أن نقترح أنهم في هذه الحالة كذلك قد اتبعوا نهج أسلافهم؛ أي ملوك البطالمة والسليوكيين، ومع ذلك فإن «قوانين الأجداد» فيما يخص اليهود كان لا يمكن أن يكون لها إلا معنًى واحدٌ، وهو نظام حكم ذاتي يهودي مؤسَّس على قوانين «موسى». ومن ثم نفهم أن التوراة كانت القانون الأساسي لكل المجتمعات اليهودية في مصر، وهذه الحقيقة كانت ذات أهمية كبيرة جدًّا للتطور الثقافي لليهودية المصرية.
ولا يوجد في الأوراق البردية ولا في النقوش أي برهان على وجود مجتمعات يهودية في العصر البطلمي، أما في العهد الروماني فإن الذِّكْر الوحيد لوجود مجتمع يهودي كان في البهنسا، ويمكن أن نستعمل هنا على أية حال مصدرًا آخر في هذا الصدد، وذلك أنه لما كانت المعابد في خلال عهد الهجرة تلعب دورًا عظيمًا بوصفها مراكز للحياة السياسية والثقافية اليهودية فإنه من المستطاع أن نسلم بأن أية إشارة لمعبد تدل على وجود مجتمع يهودي منظم، وعلى الرغم من أن المعبد اليهودي كان مؤسسة قامت بعد التوراة، فإن وجوده كان أهم صفة أساسية لقوانين الأجداد، فقد كان المعبد موضع مقابلات وتدبيرات عند اليهود كما كان للعبادة ودرس التوراة، بل لقد كان أحيانًا يعتبر مضيفة، وذلك لأنه كان متصلًا به حجرات خاصة لإضافة الغرباء، هذا وكان المعبد في البلدان الصغيرة والقرى على ما يظهر يحوي كل المؤسسات العامة للمجتمع مثل المحكمة وإدارة التسجيل.
وكان المعبد في مصر يُدعَى مكان العبادة، ولدينا نقش يدل على أن ملوك البطالمة قد منحوا بعض المعابد نفس حقوق الحماية كالتي كانت تُعطى للمعابد المصرية، ولا بد أن أعمالًا خيرية مثل هذه قد كسبت عواطف اليهود، ولدينا أمثلة عديدة تشهد تقديم اليهود معابدهم للملك وأسرته مبرهنين بذلك على شعورهم المُوالي للحكومة ورئيسها، وكانت المعابد أحيانًا يقيمها كل المجتمع اليهودي، وكان المجتمع في مثل هذه الحالات يسمى نفسه «يهود مكان كذا»، وكان يقيمها أحيانًا المجتمع بمساعدة فرد حر وأحيانًا كان يقيمها فرد حر بمفرده، وتدل المصادر التي في متناولنا على وجود معابد في عشرة أماكن (في بلدان وقرى)، ولا بد أن عددها كان أكثر من ذلك بكثير في القطر.
والقائمة التالية تبين الأماكن التي أقيمت فيها المعابد المعروفة التي جاء ذكرها في الوثائق حتى الآن:
(1) الإسكندرية: كان في الإسكندرية عدة معابد منتشرة في كل أنحاء المدينة والمبنى الجميل للمعبد الرئيسي جاء ذكره في التلمود.
(2) معبد شديا Schedia بالقرب من الإسكندرية.
(3) معبد «كزنفيريس» Xenephyris بالوجه البحري.
(4) معبد «أتريبيس» (بنها الحالية).
(5) معبد «نتريا» (وادي النطرون) بالوجه البحري.
(6) معبد «كروكوديلوبوليس-أرسنوي» بالفيوم.
(7) معبد «ألكسندرونوس» Alexandron-Nesos بالفيوم.
وهناك معابد أخرى لم تُعرف مواقعها.
وكانت هناك قرى ومستعمرات حربية يسكنها يهود، غير أنه ليس لدينا وسائل لتقرير ما إذا كان هؤلاء السكان كثيرين بما فيه الكفاية لتكوين مجتمعات يهودية، والأرجح أنه لم تكن في المستعمرات الحربية مجتمعات، ومع ذلك يمكننا أن نسلم أنه كانت توجد مجتمعات يهودية منظمة في بعض قرى «الفيوم»، ولا أدل على ذلك بصفة مباشرة من وجود معبد في بلدة «ألكسندرونسوس»، ويمكن أن يسلَّم بمثل ذلك في «بسنيريس» Psenyris حيث نجد أن كل السكان كانوا مقسمين إغريقًا ويهودًا، وكانت البلاد الصغيرة مثل «فيلادلفيا» وكذلك القرى الكبيرة التي كان يقطنها عدد كبير من الشرقيين مثل «سماريا» Samareia والمجدل Magdola (كلاهما في الفيوم) يحتمل أنه كان لهما مجتمعات يهودية خاصة بها مكونة مراكز لليهود الذين يسكنون على مقربة منها، والمجتمع الوحيد الذي يُعرف تاريخه بصورةٍ ما هو مجتمع الإسكندرية؛ فقد سجل لنا هنا «البوليتوما» اليهودية (أريستاس Arist. 310(وقد ذكر لنا نفس المؤلف «قادة السكان اليهود»، ويتساءل الإنسان إذا كان هؤلاء القادة قد نظموا أنفسهم فعلًا في مجلس شيوخ Gerousia في منتصف القرن الثاني ق.م عندما كُتبت «رسائل أريستاس»، كما كانوا قد نظموا أنفسهم فيما بعد في العهد الروماني.
والواقع أن الجواب على ذلك يتوقف على فهم متن «أريستاس» الذي لم يكن واضحًا عند هذه النقطة، ويمكننا أن نسأل فضلًا عن ذلك إذا كان القادة ينتخبهم كل السكان اليهود على حسب المبادئ الديمقراطية للمدنية الإغريقية أو كانوا يعينون أنفسهم من بين أغنى رجال المجتمع اليهودي وأعظمهم سلطانًا، والواقع أن الطريقة الأخيرة كانت تتفق كثيرًا مع الأخلاق الأرستقراطية للمجتمعات اليهودية في العالم الهيلانستيكي الروماني، ونرى أنه في نهاية العهد البطلمي وبداية العصر الروماني، وكانت شخصية الأثنارك (الحاكم) القوية تغطي على كل القادة الآخرين، ويتحدث المؤرخ «إسترابون» الذي زار الإسكندرية في عهد «أغسطس» عن الأثنارك أنه رجل يحكم المجتمع اليهودي كأنه حاكم دولة مستقلة، وكانت اختصاصاته على حسب ما جاء في إسترابون هي إدارة شئون الناس ورئاسة محكمة العدل والمحافظة على الوثائق العامة للقانون، ومن ثم نفهم أنه كان رئيس الإدارة والمحكمة وإدارة العقود، ومع ذلك فإنه ليس لدينا من الأسباب ما يكفي بأن نقول إن هذا النوع من الحكم كان استبداديًّا وحل محله آخر أرستقراطيًّا، والواقع أن سلطة «الأثنارك» لم تتعارض مع نفوذ الأسرات العظيمة التي كانت الأساس الاجتماعي للحكم الأرستقراطي في المجتمع اليهودي، ويرجع السبب في ذلك إلى أن «الأثنارك» نفسه كان متأكدًا من أنه عضو من أعضاء هذه الأسر، ومن المحتمل أن إيجاد قوة مركزية في الإدارة يدل على ما يظهر على الحكمة السياسية للأرستقراطية اليهودية في الإسكندرية وهي التي فضلت أن تترك جانبًا المشاحنات الصغيرة التي كانت تقوم بين الأسر من أجل إنشاء حكم قوي للطبقة الممتازة على كل المجتمع، ولا نزاع في أن هذا النوع من الحكم كانت الحاجة ماسة إليه ليقف في وجه الطبقات الدنيا الجامحة من السكان اليهود في الإسكندرية، هذا ونذكر من بين المؤسسات المختلفة والموظفين في المجتمع في عهد البطالمة «خزان» Neokoras المعبد (وهو موظف كبير)، وقد كان للمجتمع اليهودي الإسكندري الهام إدارة عقود ومحكمة، وكان من بين الموظفين الذين لعبوا دورًا رئيسيًّا في كل المجتمعات اليهودية للإمبراطورية الرومانية «الأركون» (الحكام الرئيسيون) وهؤلاء الحكام لم يذكروا إلا مرة واحدة في الوثائق المصرية؛ حكام اليهود من إقليم «تبياس» Tebias (في الفيوم) في مجتمع «أرسنوي»، وخلافًا لهؤلاء الحكام قد ذكر بعض موظفين آخرين، وهذه هي كل المادة التي أمكن جمعها عن المصادر الخاصة بالموظفين والمؤسسات الخاصة بالمجتمعات اليهودية في مصر.
 الاكثر قراءة في العصور القديمة في مصر
الاكثر قراءة في العصور القديمة في مصر
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











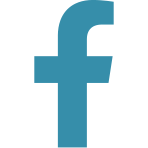

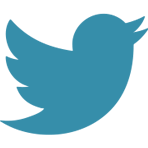

 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)