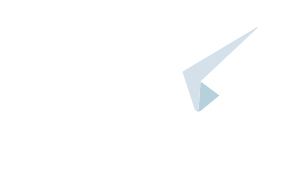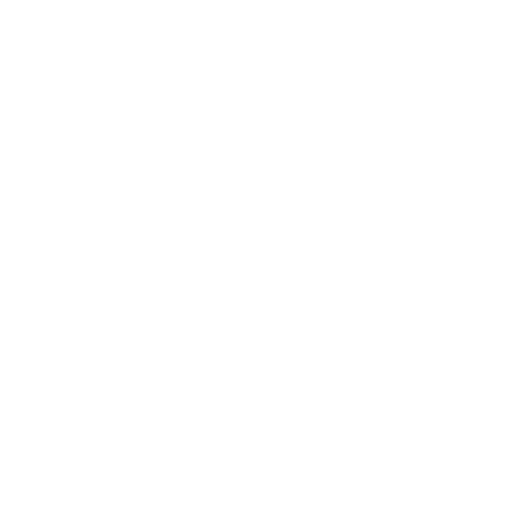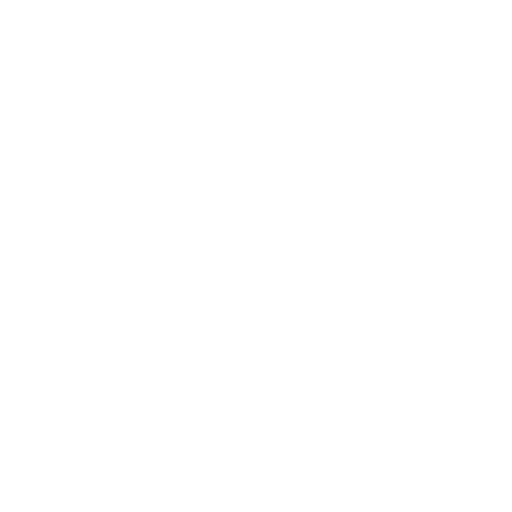تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
الشيعة تعتبر أساس تعاليم الإسلام قائم على الإمامة
المؤلف:
السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
المصدر:
معرفة الإمام
الجزء والصفحة:
ج1/ ص200-203
2025-10-18
56
تقول الشيعة انّ أساس تعاليم الاسلام قائمة على الإمامة، ففي زمن رسول الله كان صلى الله عليه وآله هو الإمام، وكان يفيض المعارف على قلوب الأمّة بقلبه اليقظ منبع علوم {فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى}[1]، ثم جرى ذلك بعده؛ بواسطة الأئمة الأطهار الواحد بعد الأخر، وصولًا إلى حضرة بقيّة الله الأعظم عجّل الله تعالى فَرَجه الشريف؛ ريّ كلّ قلب بقدر سعته من قبل مراكز الحياة والمعرفة تلك.
أمّا الموضوع الأخر وهو التسليم والخضوع والاتّباع للإمام، الذي يُعدّ القلوب لتلقّي واكتساب المعارف والعلوم، فهذه الخصوصيّة موجودة لدى الشيعة، لذا يُشاهد أنّ الشيعة يفوقون العامّة بقدر ملحوظ في صفات المحبّة والوفاء والصفاء والإنفاق والإيثار وقضاء حوائج الناس وفي رقّة القلب والعاطفة ونظائرها من الصفات الحميدة، وهذا ناجم عن روح التسليم والخضوع مقابل معلم البشريّة ومبدأ التعليم والتربية، سواءً كان الإمام حاضراً أو غائباً، لأنّ تأثير وتأثّر الأرواح لا حاجة له كثيراً إلى الحضور، لأنّه ليس مادّه ليشترط لتأثيرها في مادّة أخرى القُرب المكاني والتماسّ الخارجي، بل هو تأثير فعلية النفس الفعّالة في قابليات النفوس المستعدّة.
ولأنّ عالم الملكوت خارج عن الزمان والمكان، لذا يمكن أن نجد تأثير فعلية الآثار الحياتيّة للإمام في كلّ قلب، فإن كان الإمام في مشرق العالم وكان تابعه في المغرب، فانّ قلب التابع مع ذلك سيحصل على استفادته، كما انّ الانسان- على أثر محبّته لولده- في ذكره دوماً، سواءً كان ولده قربه أو مسافراً بعيداً عنه، فصورة الولد لا تفارقه بل مطبوعة في قلبه. وكذلك إذا ما وجدت تجليّات الإمام في قلب المؤمن أينما كان ذلك المؤمن، فانّه سوف يستمدّ ماء الحياة من ذلك المعدن اللامتناهي اثر انعكاس الصورة الحقة.
لذا فانّ الشيعة يفيدون- ولو في زمن الغيبة- من ذلك المركز للعلم والمعرفة، بسبب التفاتهم الكامل إلى مصدر الخيرات والعلوم، مع انّه لا شك هناك ولا ريب في انّ أثر حضور الإمام وفوائده أكثر وأوفر؛ خلافاً لغير الشيعة الذين لا ترتبط قلوبهم بهذا المعدن، لذا فانّ نفوسهم حائرة متردّدة ليس لها إلى الخروج عن ذواتها من سبيل.
الشيعة يمتلكون اللطف والرقّة والمداراة: يقول ابن أبي الحديد بعد أن يذكر قدراً من صفات أمير المؤمنين عليه السلام: وَقَدْ بَقِيَ هَذا الخُلُقُ مُتَوارَثاً مُتَنَاقَلًا في مُحِبّيهِ وأوليائِهِ إلى الآن، كما بَقِيَ الجَفَاءُ والخُشونَةُ والوُعُورَةُ في الجَانبِ الآخرِ، ومَن لَهُ أدْنى مَعرفَةٌ بِأخلاقِ النَّاسِ وعَوَائِدِهِمْ يَعْرفُ ذَلكَ[2].
انّ المعارف والعلوم الالهيّة تجري في قلوب اتباع الإمام اثر اتّصال قلوبهم بقلبه، كما انّ السبب في انّ للمؤمنين أنهاراً من ماء زلال في الجنّة يعود إلى تأثير ذلك الاتصال القلبي والإفادة من نبع فضائل الأئمة. ونرى كثيراً في القرآن الكريم أنّ الله تعالى يعد المؤمنين {جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ} مثل: {إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ}[3].
الجنّة تجلّي الصفات والأفعال: وكما ذكرنا فانّ الجنّة هي ظهور وبروز عالم نفس المؤمن في الأخرة، ولأنّ نفس المؤمن قد نجت، بسبب الاطمئنان بالله وبالسكينة التي حصلت عليها، من حرارة ولسع اليأس والفشل ومن طوفان خواطر الشيطان والاضطرابات الفكريّة والأخلاقيّة، فهم مسرورون فرحون في رحمة الله ومقام أمنه وأمانه، فقد عشقوا الله بنشاط ولذّة كاملين حتى في أدقّ لحظات سكرات الموت، فهم في سكينة واطمئنان، لذا فعند ما يظهر ملكوت الأشياء في الأخرة، فانّ ملكوت نفس المؤمن سيكون بصورة جنّة متشابكة الأشجار، تشابكت فيها فروع الأعمال الصالحة وأوراقها، فألقت ظلالها على الأرض، فلا مجال هناك لأشعّة الشمس اللاهبة ولا لطوفان الحوادث أو غبار الخيالات والخواطر الشيطانية.
سواءً اعتبرنا انّ الجنّة من جهة تجسّم أعمال المؤمن وظهور ملكوت النفس المؤمنة، أو بعنوان الجزاء المترتّب على العمل، فانّ النتيجة ستكون واحدة. يشهد على هذا المعنى خطاب الله تعالى إلى آدم أبي البشر قبل وروده في هذه النشأة: {فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ ولِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها ولا تَعْرى ، وأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها ولا تَضْحى}[4].
فقد خاطب الله آدم: انّ هذه الجنّة لا خواطر نفسانية فيها ولا اضطرابات للخيال والقوى الواهمة، هناك حيث لا تجوع ولا تعرى، ولا تظمأ ولا تضحى بحرارة الشمس، فالجوع والعُرى والحرارة والانصهار كلها من أثر تسلّط النفس الأمّارة بالسوء على الإنسان، أمّا في الجنّة حيث قلب الإنسان مطمئنّ هادئ بعيد عن الخواطر والانفعالات، هناك حيث الاستقرار والاستراحة في {مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ}[5].
فالذين يغادرون الدنيا إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة هم الذين يدخلون الجنّة ويتمتّعون فيها تحت ظلال الأشجار المتكاثفة.
[1] الآية 10، من السورة 53: النجم.
[2] (شرح نهج البلاغة)، الطبعة ذات العشرين مجلّداً، ج 1، ص 26.
[3] الآية 14 و23، من السورة 22: الحجّ؛ والآية 12، من السورة 47: محمد.
[4] الآية 117- 119، من السورة 20: طه.
[5] الآية 55، من السورة 54: القمر.
 الاكثر قراءة في مقالات عقائدية عامة
الاكثر قراءة في مقالات عقائدية عامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











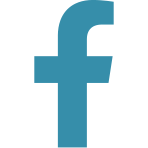

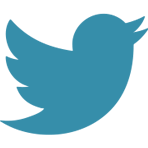

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)