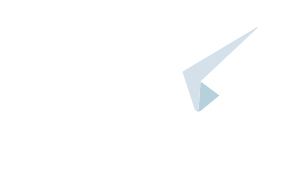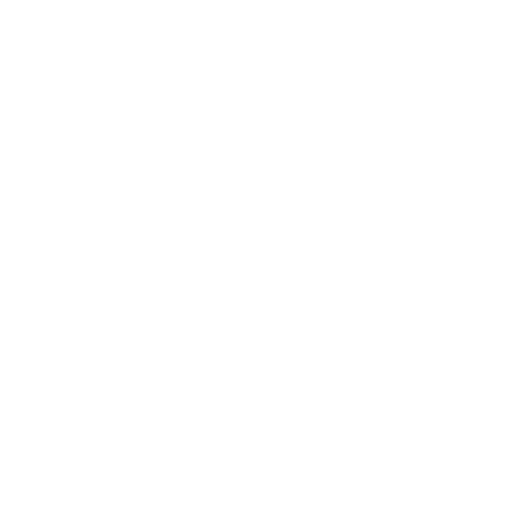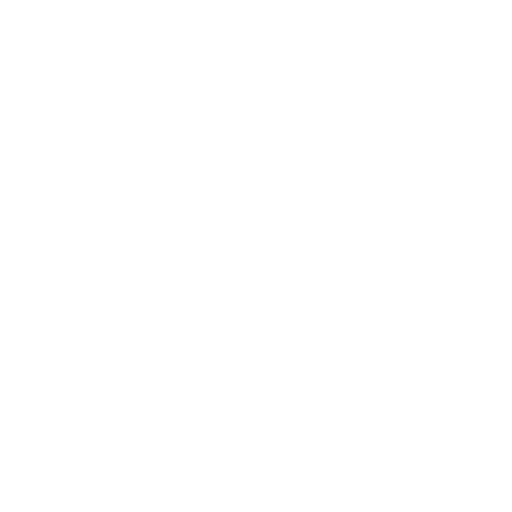الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات


المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية


التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة
آفاق المستقبل
المؤلف:
أ. د. عبد الكريم بكَار
المصدر:
حول التربية والتعليم
الجزء والصفحة:
ص 351 ــ 363
2025-07-24
37
حين نطلق كلمة (مستقبل) فإننا نريد في العادة أحد معنيين: الأول هو الثمار والنتائج التي نتوقع أن تفضي إليها مجموعة من العوامل والأسباب والمعطيات الكائنة، على النحو الذي تسمح به خبرتنا بالواقع المعيش وشفافيتنا صوب التطورات والتوجهات في مجال من مجالات الحياة.
أما المعنى الثاني فيتمحور حول الآمال والمنجزات التي نرى ضرورة تحقيقها في المستقبل بقطع النظر عن مدى توفر المقدمات والإمكانات التي تقود إليها. وحديثنا هنا عن آفاق مستقبل التربية والتعليم يجري وفق المنظور الثاني.
كثيراً مما يتعين علينا إنجازه في مضمار التعليم، من خلال الإلماحات التالية:
1- أهمية النظر إلى المستقبل:
إن التطلع إلى المستقبل ضروري للخروج من أية أزمة، إذ إنه الكوة الصغيرة التي نتنفس منها عبق الاستمرار والتأبي على الاستسلام للمشكلات القائمة مهما كانت ضراوتها.
إن التفكير بالمستقبل، قد يكون هو الوسيلة لتنظيم الاستفادة من الإمكانات الحاضرة وظاهر في حياة الأمم التي ليس لديها طاقة تسخرها للتفكير فيما هو آت أنها تضيع الحاضر، وتبدد كل فرصة متاحة. وبعض الناس ينظر إلى المستقبل بروح الأمل والرجاء دون أن يحسّن من الوضعية الحاضرة، فتزداد أحواله سوءاً يوماً بعد يوم، وكأن ما يحصد يمكن أن يكون من غير جنس ما يزرع!.
حتى نؤطر التفكير في المستقبل، فإن علينا أن ندرك أن كل ما نتطلع إليه، ونتمناه، لن يكون كاملاً ما دامت أحوالنا غير كاملة؛ فمن غير الممكن أن نعثر على حلول كاملة في وسط غير كامل وإن الأزمة حين تلف كل المجتمع، فإن المربين وحدهم، لا يستطيعون إنجاز الكثير. ولذا فإن ما ندعو إلى إنجازه في حقل التربية والتعليم مثلاً - لن يتحقق ما لم نحسن من الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في حياتنا؛ فالنهوض الشامل هو الذي سيهيئ الفرص لكل الإمكانات أن تتفتح، ولكل الأيدي أن تعمل.
2- الدقة في تصوير الأزمة:
إن وجود أزمات ووجود طموحات وتطلعات من الأمور الطبيعية في حياة البشر، لكن المشكلة تكمن في عدم فهم الأزمات على نحو صحيح وفي بناء تطلعات كبيرة على إمكانات هشة غير ملائمة؛ وهذا ما يحدث لدينا بكثرة. إننا كثيراً ما نرتبك في توصيف موضع المعاناة بدقة، حيث إن ما تراكم لدينا من معارف وخبرات في هذه المسألة محدود بالنسبة لما لدى الأمم الأخرى. إننا بحاجة إلى أن نتعلم مهارات توصيف الأزمات وشرحها وتحديدها وبيان ارتباطاتها وتاريخها... إن كل مشكلة يمكن توصيفها على نحو جيد هي مشكلة محلولة جزئياً، وإن مما يساعدنا على ذلك أن نقارن بين ما لدينا وبين ما لدى الآخرين فالوعي بالذات كثيراً ما ينبع من الوعي بالآخر. ولتنظر دائماً إلى ما يمكن أن يكون لو أننا أحسنا الاستفادة مما بين أيدينا من إمكانات والمهم دائماً أن تفرق بين المرض وأعراضه؛ فالإخفاق الدراسي قد لا يكون أكثر من نتيجة لسوء طريقة التدريس أو سوء المنهج أو ضيق سوق العمل... والمهم كذلك ألا نضخم المشكلات حتى نرى أنفسنا عاجزين عن عمل أي شيء لها، وألا نبسطها إلى درجة الشعور بأنه ليس هناك ما يستدعي القلق. إن من الموضوعية في هذا الشأن ألا تكون تصورات عن مشكلاتنا انطلاقاً من أفق محدود أو محيط ضيق - كما يحدث دائماً - فإذا ما رأينا حالات سيئة في مدرسة ما لم يجز لنا أن نعمم الحكم على جميع المدارس في منطقة أو في دولة، فالعوامل التي تتحكم في وجود ظاهرة ما كثيرة جداً، والوقوف عليها وتقديرها ليس بالأمر اليسير، وبعض تلك العوامل قد يكون خاصاً.
سوف نتريث كثيراً في إطلاق الأحكام المصورة لأزماتنا إذا ما عرفنا أن فهم الواقع على نحو دقيق هو شيء يلبي وخاضع لاعتبارات كثيرة ولاسيما في ظل شح المعلومات، وقلة الدراسات في معظم ما يخص المؤسسات والأنشطة التربوية. علينا أن نهيئ أنفسنا لتقبل وجهات نظر عديدة - وأحياناً فجة - في كل ما يمت إلى تصوير الواقع وفهمه.
3- العثور على منهج للتعامل مع المشكلات:
حين نشعر أن هناك أزمة فإن المرحلة التالية، هي البحث عن حل لها، وهناك اليوم تياران كبيران في مناهج البحث العلمي: التيار (الكمي) والتيار (الكيفي)، وينضوي تحت كل واحد منهما عدد من المناهج البحثية الفرعية، ولكل منهما ميزاته المعروفة لدى الباحثين. إلى جانب هذا يشعر كثيرون من المفكرين والاختصاصيين بأن ما اخترعه البشر من مناهج وأساليب لفهم المشكلات، يمر هو الآخر بأزمة، وهذا طبيعي؛ فكل ما يخضع لقواعد وقوانين محددة يتعرض لخطورة التصلب والقصور عن أداء مهامه. وإن ما يتم كشفه اليوم من مناطق المجهول، قد زاد من عجز مناهج البحث السائدة عن التعامل مع المزيد من الجزئيات وتفسيرها.
إن العقدة في حقل حل المشكلات دائماً هي: العثور على منهج ملائم لطبيعة المشكلة، وقد تعود كثير من الناس - كالصحفيين مثلاً - أن يعتمدوا على الحدس في فهم المشكلة وحلها، ومع أن للحدس موقعه المهم في ذلك إلا أن الاعتماد عليه وحده، يوجد مشكلات كثيرة، فلا بد من اختيار ما نحدس به والبرهنة عليه. إن من سمات النظرية الجيدة والمنهج الجيد فتح الطريق أمام العمل والتطوير، وكل نظرية، توصل الناس إلى طريق مسدود، ليست بنظرية، والنظرية الجيدة كذلك نظرية منتجة، أي قابلة للدراسة والنقد وتوليد المزيد من البحث العلمي؛ وهذا يوجب علينا ألا نحمل الأفكار التي نتوصل إليها من الجزم والقطع أكثر مما تتحمله طبيعتها. ونعكس إيماننا بذلك بأن نصوغ أحكامنا بأسلوب اجتهادي مرن، ومنفتح على ما يمكن أن يستجد من خبرات ومفاهيم جديدة، وحتى نفعل ذلك فلا بد من إعطاء الخيال الفرصة للمشاركة في أي منهج نستخدمه في التخطيط والمعالجة. إن كثيراً من الناس يعيشون وفق أخيلتهم، والمحرومون من الخيال الخصب، يسجنون أنفسهم في مقولات وقواعد كثيراً ما تكون بالية وقاصرة، وطالما أتاح الخيال الخطب ارتياد آفاق رحبة، لا يدركها الحرفيون وذوو التفكير الجزئي.
من المهم ونحن في سياق علاج مشكلاتنا أن نملك فضيلة الانتظار والصبر على التصحيح، فالمسائل التربوية ذات بعد إنساني عميق، وكل ما يتصل بالإنسان يتسم بالتعقيد والعناد، ويحتاج علاجه إلى وقت، ومع الوقت الاهتمام والذكاء ورحابة الأفق، ولكن لا قيمة لكل هذا إلا بعد أن نتأكد أننا في المسار الصحيح.
4- تحدي الدفق المعلوماتي:
الدفق الهائل للمعلومات في عصرنا الحاضر يزداد شدة، ولا يدري أحد حجم التحديات التي ستنبثق عنه خلال السنوات العشر القادمة، لكن يمكن أن يقال: إن هذا التواصل المعلوماتي، هو سلاح ذو حدين، فهو من وجه سيمكن من إلقاء الضوء على الأزمات والاختناقات التي تعاني منها الأعمال التعليمية، كما سيوفر كياناً كبيراً من المعرفة المنظمة التي ستساعد على إصلاح التعليم، إلى جانب تنمية حاسة المقارنة لدى الناس، والقائمين على المؤسسات التربوية.. ومن وجه آخر فإن ما سيسمعه الطالب، ويراه في الوسائل الإعلامية سيكون أكثر وأحدث مما يتلقاه في المدرسة، وهذا يمثل في حد ذاته تحدياً جديداً للمدارس، ويفرض عليها أن تغير من أساليبها وبعض أهدافها أيضاً؛ فالمدارس لن تستطيع مجاراة وسائل الإعلام وشبكات المعلومات في تقديم المعارف المتطورة والطازجة للطلاب؛ مما يعني أن على المدارس أن تركز جهودها في حقل آخر، وأن تساعد منسوبيها على التعامل مع هذا السيل الجارف من المعلومات بحكمة وفاعلية. ويمكن أن تلخص ما تعنيه هنا في النقاط التالية:
أ- تدريب الطالب على التعامل مع مصادر المعلومات، كالمراجع ودوائر المعارف و(بنوك) المعلومات وشبكات المعلومات مثل (الإنترنت) ويجب أن نضع في اعتبارنا الثورة الهائلة التي تتفجر اليوم في تخزين المعلومات واسترجاعها، نتيجة استخدام الوسائط الضوئية ذات سعة التخزين الهائلة وأسلوب النص الفائق (1).
إن تعليم طالب كيفية الرجوع إلى معجم أفضل مئة مرة من تحفيظه معاني ألف كلمة في اللغة.
ب- على مؤسساتنا التعليمية أن تصرف جزءاً من اهتمامها إلى تكوين عقلية راشدة لدى الطلاب، وقادرة على الفهم الموضوعي للأشياء، وعلى النقد والربط بين العلة والمعلول، والسبب والمسبب، وعلى الانتفاء واستخراج المغزى الذي توحي به الأفكار والمعلومات المتداولة، بالإضافة إلى القدرة على الحكم على الأخبار الواردة إليهم، وغربلتها وتمييز الغث من السمين منها. وسيكون من مهامها على نحو خاص تعليم الطلاب (الدقة) في الفهم والتعبير، ومحاولة تمليكهم القدرة على رؤية الأشياء بطرق جديدة خارج الطرق المألوفة، وحب الوضوح والحساسية الثقافية تجاه المقولات المختلفة.
وما لم تفعل ذلك فإن الشباب سيكونون معرضين للغرق في بحار المعلومات والمعارف المتقاطعة والمتضاربة، والتي كثيراً ما تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وتذاع بدوافع سياسية وتجارية وعنصرية.
ج- التدفق المعلوماتي، يتجه من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال إلى الجنوب، وهو - بالطبع - لا ينقل إلينا أسرار التقنية أو التفوق الغربي، وإنما ينقل مظاهر التفوق الغربي، كما يشيع بيننا معالم ثقافة أجنبية ومغايرة لثقافتنا، وهي ثقافة متسقة داخلياً، وذات جاذبية في أجزاء عديدة منها. والمطلوب من مدارسنا اليوم أن تحصن الشباب المسلم من الانزلاق إلى أوحال تلك الثقافة. ويبدو أن أداء المدارس في هذا الشأن ليس كما ينبغي؛ حيث نرى لدى كثير من الطلاب إحساساً ضعيفاً بهويتهم الإسلامية، إلى جانب سيطرة النزعة الاستهلاكية عليهم، والمعاناة من الضياع والعزلة والفقر الروحي والانبهار بالتقنية، وحب التقليد، والتعلق بالقشور والمظاهر الفارغة!
إن الطالب ليس بحاجة اليوم إلى التمتع بعقلية جيدة فحسب، وإنما هو بحاجة إلى نوع من الإحياء الكلي: العقلي والنفسي والروحي والشعوري، مع ملاحظة التوازن والانسجام بين هذه الجوانب. وهذا لن يتم ما لم نحاول زيادة فاعلية التعلم لدى الطالب واستثمار كل طاقاته، مع المحافظة على كرامته وحريته، إلى جانب إشاعة روح المشاركة والتعاون بين الطلاب، والتركيز على أن يتحمل الطالب المزيد من المسؤولية في تثقيف نفسه وإثراء شخصيته.
5- تفعيل المشاركة الاجتماعية في التعليم:
تعلمنا من تجربتنا التاريخية ومن تجارب الأمم من حولنا أن الضمانة الوثيقة لنجاح أي مشروع، تكمن في تبني المجتمع له؛ فلا نجاح لأية خطة ما لم يستطع القائمون عليها إقناع المجتمع بها، ليجعلها جزءاً من همومه واهتماماته؟ وكل حمل يتم خارج رحم الأمة ورحم المجتمع، هو كالحمل الكاذب!.
مشكلات التربية واكتساب المعرفة ليست مشكلات مدارس أو طلاب أو دول، وإنما هي تجسيدات لمشكلات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية، تعاني منها أمة بأكملها، وينبغي أن يكون لكل فرد منها وظيفة ما في التخفيف من وطأتها.
سيكون من الهموم الكبرى لقادة الفكر والرأي والمشرفين على المؤسسات التربوية والثقافية - النجاح في إقناع الفرد في مجتمعهم بتقبل المزيد من التثقيف والنمو المعرفي في المجال الذي يهمه، أو الحرفة التي يعمل فيها. والذي يحول دون ذلك دائماً مجموعة من الحتميات الفلسفية والنفسية والاجتماعية؛ وليس أمامنا من خيار سوى مواجهة تلك الحتميات وتفتيت المشكلات الناتجة عنها؛ وهذا يحتاج منا أن نقيم الهياكل والمضامين الثقافية السائدة في ظل المقارنة بثقافات الأمم المعاصرة. وهذا سيقوي ثقة الناس بأنفسهم وثقافاتهم على خلاف ما يتبادر إلى الذهن.
إن النهوض بالتعليم بحاجة ماسة إلى مساهمة الناس جميعاً، وعلى جميع المستويات؛ فالتعليم حتى لا يتحجر، وينغلق على نفسه بحاجة إلى نقد اجتماعي قوي، وينبغي على (الرأي العام) أن يضغط على المؤسسات التربوية، ويحملها على تطوير نفسها لما فيه المصلحة العامة. وأعتقد أن قضية كقضية التربية تستحق ملحقاً في جريدة كل سنة، ونصف صفحة كل أسبوع، يتم فيها مناقشة أنشطة المدارس وتقييمها، وما دامت المؤسسات التعليمية، قد قامت في الأصل لخدمة أبناء الناس، فمن حق الناس أن يثمنوا تلك الخدمة، ويكشفوا عن مواطن الخلل فيها.
المدارس من وجه آخره لا تستغني عن نصح الأهالي، فأفكار التطوير كثيراً ما تأتي من جهات بعيدة عن مجال التربية ويحتاج مجال العلاقة بين البيت والمدرسة إلى تنظيم وإيجاد آليات لتفعيل التشاور، وقبل ذلك إلى ثقافة تدفع دفعاً إلى تقديم النصح والمعونة إلى المؤسسات التربوية والعامة. لا نريد أن تكون الحلول المقدمة لحل مشكلات التعليم ثمرة جهود جهاز واحد، وإنما ثمرة الاستماع إلى كل أولئك الذين يعنيهم الأمر، وعلى المدارس أن تسهل سبل الوصول إلى التعاون المثمر من خلال مجالس الآباء ولجان أصدقاء التربية والزيارات المتبادلة بين المدارس والبيوت... ولا تستطيع المدارس أن تحصل على ما تريد من دعم الأهالي ما لم يشعروا أن اقتراحاتهم تؤخذ مأخذ الجد والاهتمام، نحن بحاجة إلى علاقة شفافة بين المجتمع والمدرسة وسيكون من المفيد أن تصمم المدارس استبانات يملؤها الأهالي، تدور حول أداء المدارس على المستوى المعرفي والسلوكي وستكون الفائدة أعظم إذا شكلت لجان مشتركة لتحليل تلك الاستبانات واستخلاص النتائج منها، ثم اتخاذ القرارات الإصلاحية بناء عليها.
التعليم من جهة أخرى بحاجة إلى العون المادي من الأهالي فالحكومات من الآن فصاعداً سوف تواجه شحاً في الموارد المادية المخصصة للتعليم، وستزداد متطلبات التعليم على مستوى الكم ومستوى الكيف وليس هناك سوى أحد خيارين إما انحطاط التعليم وتراجعه، وإما إيجاد سبل وأطر لمشاركة الأهالي في دعمه إن الناس في كثير من بلاد المسلمين، قد صار عندهم نوع من الإدمان على الخدمات المجانية غير أبهين بالنتائج التي ستترتب على ذلك، إن مبلغاً يسيراً في الشهر، يشكل 3 % من دخل رب الأسرة، يؤخذ من الطالب لا يؤثر على تكاليف معيشة أهله، لكنه يؤدي إلى تحسين مستوى خدمات المدرسة، ويساعدها على تنظيم برامج وأنشطة مفيدة وكثيرة، لا يمكن أن تقوم بها من غير مال.
وربما يكون من الأصلح أن يتم إنفاق دعم الأهالي في التجهيزات المدرسية، مثل المكتبات والمعامل وأجهزة الحاسب، وتمويل الأنشطة غير الصفية وغير ذلك مما يسهم في رفع كفاءة التعليم. وهذا لن يشكل في الحقيقة أي خسارة لأولياء الأمور حيث سيستردون ذلك أضعافاً مضاعفة في نوعية إعداد أبنائهم للحياة، في العالم دول كثيرة، تتقاسم تكاليف التعليم مع الأهالي؛ ففي كوريا الجنوبية - مثلاً - تحاول الدولة أن تبقي تكاليف التعليم منخفضة، وتحمل الأهالي جزءاً منها، وهي تخفض الدعم الحكومي للتعليم كلما تقدم الطلبة في مراحل الدراسة، إلى أن يصل الأمر إلى تحميل الأهالي نحواً من 50 % من نفقاته (2).
ربما احتاج كل ما ذكرناه إلى أمر إداري هام، هو تخفيف المركزية في الإشراف على المدارس، إذ من حق أهل كل منطقة أن يشعروا بتميز مدارسهم، وتجاوب المناهج مع نوع المعرفة الذي يحتاجونه في إطار هيكل معرفي عام تشرف عليه الدولة. وهناك دول معروفة بالمركزية الشديدة في كل شيء، ثم وجدت أنه لا سبيل إلى مشاركة الناس دون تفويض أجزاء من التخطيط التربوي والإشراف والتطوير إلى الأهالي؛ فالصين - مثلاً - قامت عام 1986 بتفويض تطوير التعليم الابتدائي للسلطات المحلية في المناطق والأقاليم (3).
إن تخفيف المركزية في التعليم، سيجعل الناس يشعرون بالقرب من إدارات المدارس، كما سيقوي يقينهم بجدوى الاقتراحات والأفكار التي يبدونها، كما سيمكنهم من إدراك حاجات المدارس على نحو أفضل؛ وهذا كله سوف يسهل عملية البذل والدعم المادي المطلوب منهم.
6- تطوير نظم التعليم:
من غير الممكن أن نحل مشكلات التعليم، وأن نزيد من فاعليته من غير أن نطور نظمه، فالسكان في زيادة مستمرة، والمهارات التي يحتاجها. الشباب أكثر بكثير مما كان مطلوباً في السابق، والتسرب من المدارس كبير، ولا سيما في البلاد الإسلامية الأشد فقراً، وهذا كله يتطلب أن يجد الناس أمامهم أطراً متنوعة وبدائل عديدة لما هو سائد اليوم من نظم التعليم.
من حق كل فتى وكل فتاة أن يجدا المؤسسة التعليمية التي تقدم ما يحتاجانه من علم ومهارة، مهما كان ظرفه أو ظرفها، ومهما كانت إمكاناته أو إمكاناتها، فذلك شرط أساسي للقضاء على الأمية الأبجدية والأمية الدينية والأمية الحضارية، وشرط أساسي لنفض غبار التخلف الذي نعاني منه.
ما زالت المدرسة هي المكان الأكثر ملاءمة لتعليم الأعداد الضخمة من الأولاد، لكن لا بد من أن تكتسب مرونة في أوقات الدوام، وفي المناهج التي تقدمها. سيكون من الضروري أن يجد أولئك المشغولون في الصباح وقتاً في المساء للدراسة، وأن يجد أولئك الذين لا يجدون أي وقت للتردد على المدرسة الجهة التي تهيئ لهم الدراسة بالمراسلة، وتبرمج لهم المعرفة، وتمنحهم الشهادة المناسبة.
إن نظم التعليم في العالم متشابهة في كثير من الأحيان، وهناك تنويعات عديدة، وجدوى النظام، لا تنبع - في أكثر الأحيان - من طبيعته وإنما من ملاءمته وتلبيته للحاجات المعرفية والعملية للشباب والناشئة، ولذا فإنه يتعين على كل قطر إسلامي أن يجرب ما تتطلبه أوضاعه الخاصة من تطوير وتجديد في نظمه التعليمية. هناك أساليب عديدة، يمكن اتباعها، كما أن هناك نماذج كثيرة جربتها بعض الدول، ويمكن الاستفادة من كل ذلك.
من الباحثين من يرى أن من أساليب تطوير نظم المدارس، أن يعهد لإحدى كليات التربية في كل منطقة بتبني الإشراف على مدرسة من مدارس وزارة المعارف، حيث تتضافر جهود أساتذة الكلية في التخطيط لتلك المدرسة وإدارتها، وتقديم طرق تدريس حديثة ومتطورة فيها، ويوضع لها نظام امتحانات جديد مع المحافظة على أهداف كل مادة؛ كما أنه يتم تجريب نظام جديد للدوام وارتباط الأساتذة بالطلاب، ويتم تقويم نتائج تلك التحديثات على نحو مستمر، حتى تصل إلى عدد من النماذج الجيدة التي نشعر بوفائها بحاجات الناس، وتتلاءم مع ظروفهم، ثم تعمم تلك النماذج على المناطق كافة (4).
في بريطانيا أثبت تطوير بعض النظم التعليمية جدواه، حيث يتم في بعض المدارس تقديم برامج خاصة، تتداخل فيها الخبرة العملية مع الخبرات المدرسية، وفي بعض دول أمريكا الجنوبية تمت إقامة مؤسسات في مستوى المدارس الابتدائية والمتوسطة، هي أشبه بوحدة إنتاجية، يتعلم فيها الطلاب إنتاج الحاصلات الزراعية، والقيام ببعض الأعمال الخشبية من أجل الاستعمال الشخصي أو البيع، وتترابط فيها مهارات القراءة والكتابة ومهارات العلوم الطبيعية والتقنية مع العملية الإنتاجية، وتكون محوراً لها (5).
إن جوانب القصور في التعليم العام، إلى جانب الظروف والأحوال الصعبة لكثير من الطلاب تجعلنا نتساءل: كيف يمكن أن نشبع الحاجات التعليمية لأولئك الأشبال والشباب الذين يقعون خارج مسؤولية أية وزارة في البلد، وهم في الحقيقة كثر. والسؤال الأكثر إلحاحاً، هو كيف يمكن تطوير نظم التعليم الرسمي، وتحقيق التعاون بينه وبين التعليم غير الرسمي وغير النظامي لمعالجة حالات التسرب بين الطلاب الشائعة والكثيرة في طول العالم الإسلامي وعرضه؟؟
7- إعادة النظر في المناهج:
ربما كانت المناهج من أكثر العناصر التعليمية حاجة إلى النظر المتكرر والمراجعة الدائمة؛ فهي مرتبطة إلى حد كبير بعمليات إعادة التوازن للمجتمع، وتأهيل الطلاب لمعايشة المستجدات في جميع مجالات الحياة. لا يغيب عن البال أن التطرف في التجديد والتطوير، ليس بالشيء الحميد، حيث لا يشترط أن يكون الجديد أجود من القديم، ولذا فإنه لا بد من أن يصاحب التجديد وعي عميق بضرورة البحث العلمي في واقع المناهج السائدة وتحليلها، والتعرف على أوجه الجمود والقصور فيها. وأعتقد أن هناك جانبين لتطوير المناهج في عالمنا الإسلامي، هما:
أ- إن المناهج التي يدرسها الطلاب في التعليم العام غير كافية لتأسيس معرفة دينية وتاريخية وحضارية جيدة فساعات (التربية الدينية) في السواد الأعظم من الدول الإسلامية غير فعالة، وغير كافية لتأسيس معرفة دينية حسنة. كما أن حاصل ما يتعلمه الطالب عن تاريخ الأمة وحضارتها، هو الآخر ضئيل، مع أن الأمم تتخذ من تاريخها وحضارتها أداة في تربية الناشئة، وأداة لتوكيد انتمائها، ومع أن البنية الثقافية الإسلامية مهددة اليوم بالوافدات الأجنبية؛ مما يستلزم تركيزاً جيداً على العلوم الشرعية والإنسانية، وصياغة مناهج على نحو يرفع من درجة حساسية الشباب نحو الحلال والحرام ويبصرهم بالإنجازات الحضارية الإسلامية، والتحديات التي تواجه أمة الإسلام في العصر الحديث، والإمكانات المتوفرة لها.
ب- نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا مناهج معاصرة حقاً في طبيعة تصميمها، وفي نوعية الموضوعات التي تتناولها. ولا يكفي أن تعرض المناهج معلومات جيدة وموثوقة، بل لا بد من أن تدل الطلاب على جوانب التأزم في المعارف المتداولة، إلى جانب تلك المشكلات التي لم تظفر بحلول ناجعة، فهناك العديد من المجالات والمسائل التي تتطلب معارف جديدة، ولا سيما في المجال الأخلاقي والإنساني، ونظراً للتغير السريع في كل شيء فإن الطالب يحتاج اليوم إلى أن يتعلم كيف يختار القراءات الراشدة المتعلقة بشخصه، وكذلك كيفية التعامل مع المتغيرات. وهذا لن يتم إلا من خلال احتواء المناهج على معرفة رفيعة ورصينة، تقوم على التحليل والتعليل والربط وليس على الوصف والسرد التقريري (6).
إن زماننا هذا يتطلب جيلاً يعرف خصوصيته الحضارية، ويتمتع بدرجة جيدة من العقلانية والمرونة إلى جانب النظرة البعيدة المدى، والاستعداد للعمل ضمن فريق، وهذا هو المحك الحقيقي لفعالية أداء المناهج لوظيفتها التثقيفية والتربوية.
لا بد لتحقيق درجة جيدة من (المعاصرة) أن يطلع الطلاب على ما يستجد في القضايا الكبرى في مسائل البيئة والصراع على الموارد، ومسائل العنصرية والهندسة الوراثية، والاتجاه العام للنظم الدولية الجديدة، وما شابه ذلك، مما يشكل لدى الطلاب وعياً عاماً بالتطورات الكبرى ذات الأثر في حياة البشرية. حتى تستطيع المناهج تكوين العقول المرنة، لا بد أن تكون هي على درجة من المرونة؛ وهذا يقتضي أن تخفف من تقديس الكتاب المدرسي الذي لن يقدم للطلاب كل ما يحتاجونه؛ وذلك من خلال تطوير طرق التعليم، حيث يمكن التخفيف من الاعتماد على الكتب المدرسية من خلال إعطاء مساحات أوسع للحوار والنقاش خلال الحصص الدراسية، ومن خلال تكليف الطلاب بكتابة البحوث والتقارير العلمية عن بعض الموضوعات، ومن خلال المطالعة الحرة في المكتبة في بعض الموضوعات التي تعرضها المناهج المدرسية.
سوف نحدث الكثير من التغيير في مناهجنا إذا تمكنا من تحديد مواصفات الشاب القادر على خوض غمار حياة صعبة، والمنتمي إلى خير أمة أخرجت للناس ولله الأمر من قبل ومن بعد.
إضاءة: إن أدبياتنا تعلمنا أن أفضل طريقة لمواجهة التحديات الخارجية هو تدعيم الذات وإصلاح الداخل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ العرب وعصر المعلومات: 393.
2ـ وضع الأطفال في العالم عام 2000: 42.
3ـ أنظمة التعليم وتحديات العصر: 153.
4ـ انظر: حول هذا بحوث مؤتمر التعليم وتحديات القرن (21)، ص 137.
5ـ أزمة العالم في التعليم: 305.
6ـ انظر: رؤية مستقبلية لدور التعليم والبحث العلمي: 40.
 الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
الاكثر قراءة في التربية العلمية والفكرية والثقافية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











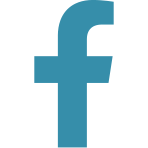

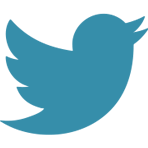

 (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)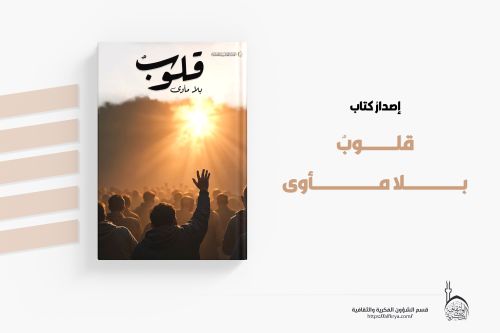 قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)