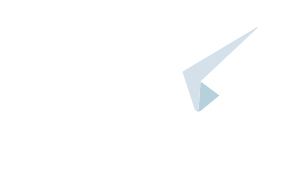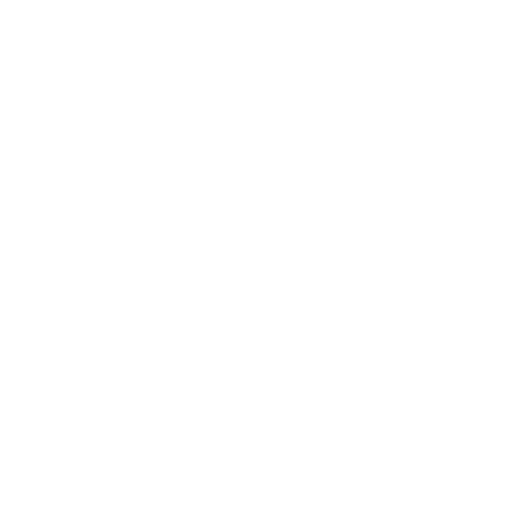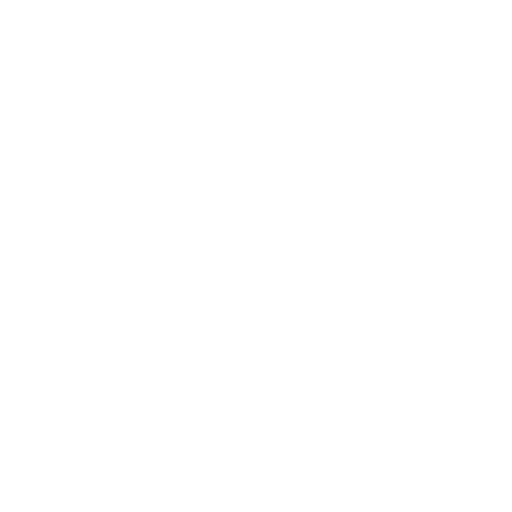التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته


صفات الله تعالى


الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه


العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة


النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

مواضيع متفرقة

القرآن الكريم


الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم ومودتهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة


المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة


فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية


شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية


أسئلة وأجوبة عقائدية


التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد


القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة


الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم


أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات


احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة


أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات


اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة


الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة
عقيدتنا في الإمامة
المؤلف:
آية الله السيد محسن الخرّازي
المصدر:
بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية
الجزء والصفحة:
ج2، ص 5- 39
2025-10-25
356
نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة.
وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا أو سلبا فإذا لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز فيها التقليد لكونها أصلا، فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى واجب عقلا، وليست كلها معلومة من طريقة قطعية، فلابد من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه إما الامام على طريقة الامامية أو غيره على طريقة غيرهم.
كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله تعالى فلا بد إن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم.
وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول.
فلذلك نقول: إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس، فليس لهم إذا شاؤوا أن ينصبوا أحدا نصبوه وإذا شاؤوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، ومتى شاؤوا أن يتركوا تعيينه تركوه، ليصح لهم البقاء بلا إمام، بل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم بالحديث المستفيض.
وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى سواء أبى البشر أم لم يأبوا، وسواء ناصروه أم لم يناصروه، أطاعوه أم لم يطيعوه، وسواء كان حاضرا أم غائبا عن أين الناس، إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب، صح أن يغيب الإمام، ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها.
قال الله تعالى: " ولكل قوم هاد " الرعد: 8 وقال: " وإن من أمة إلا خلا فيها نذير " [فاطر: 22] (أ).
_______________
(أ) يقع الكلام في مقامات:
المقام الأول: في معنى الامامة لغة: وهو بحسبها تقدم شخص على الناس بنحو يتبعونه ويقتدون به ، فالإمام هو المقتدى به والمتقدم على الناس.
قال في المفردات: والامام المؤتم به انسانا كان يقتدى بقوله او فعله او كتابا اوغير ذلك ، محقا كان أو مبطلا، وجمعه أئمة، انتهى موضع الحاجة منه. وعن الصحاح: الإمام الذي يقتدي به وجمعه أئمة، ويشهد له الاستعمال القرآني كقوله عز وجل: " وجعلنا هم أئمة يهدون بأمرنا " (1) وقوله تبارك وتعالى:" وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار " (2) إذ الظاهر أنه ليس مستعملا في هذه الموارد إلا في معناه اللغوي. ثم إن الإمام إن كان إماما في جهة خاصة يقيد بها، ويقال: إنه إمام الجماعة أو إمام الجمعة أو إمام العسكر ونحوها وإلا أطلق وعلم أنه إمام في جميع الجهات، كقوله تعالى في حق إبراهيم الخليل - عليه السلام -: " إني جاعلك للناس إماما " (3).
ومما ذكر يظهر أيضا أن الإمام لغة أعم من الإمام الأصل وغيره، كما أنه أعم من الإمام الحق وغيره، وإن كان في بعض المقامات ظاهرا في الإمام الأصل في تغفل.
ثم إن النسبة بين الأمام بالمعنى المذكور والنبي - سواء كان بمعنى المخبر عن الله تعالى بالإنذار والتبشير كما هو الظاهر أو بمعنى تحمل النبأ من جانب الله كما يظهر عن بعض - هي العموم من وجه فيمكن اجتماعهما في شخص واحد كما قد يجتمع عنوان الإمام مع عنوان خليفة الرسول أو وصي الرسول.
المقام الثاني: في معنى الإمامة اصطلاحا: ولا يذهب عليك أن جمهور العامة فسروها بما اعتقدوه في الإمامة من الخلافة الظاهرية والإمارة، وقالوا: إن الإمامة عند الأشاعرة هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة (4) ومن المعلوم أن مرادهم منها هي الخلافة الظاهرية التي هي إقامة غير النبي مكانه في إقامة العدل، وحفظ المجتمع الإسلامي، ولو لم ينصبه النبي - صلى الله عليه وآله - للخلافة بإذنه تعالى، ولذا حكي عن شرح المقاصد أنه قال: إن قيل الخلافة عن النبي - صلى الله عليه وآله - إنما تكون فيما استخلفه النبي - صلى الله عليه وآله -، فلا يصدق التعريف على إمامة البيعة ونحوها، فضلا عن رياسة النايب العام للإمام.
قلنا: لو سلم فالاستخلاف أعم من أن يكون بواسطة أو بدونها (5)، ولذا لم يشترطوا فيها العصمة، بل لم يشترط بعضهم العدالة، كما قال شارح المقاصد على المحكي: إن من أسباب انعقاد الخلافة القهر والغلبة، فمن تصدى لها بالقهر والغلبة من دون بيعة الأمة معه فالأظهر انعقاد الخلافة له، وإن كان فاسقا (6)، ونسب ذلك أيضا إلى الحشوية وبعض المعتزلة (7)، كما لم يشترطوا فيها العلم الإلهي، بل اكتفوا فيها بالاجتهاد ولو كان اجتهاد ناقصا قال الفضل بن روزبهان: ومستحقها أن يكون مجتهدا في الأصول والفروع ليقوم بأمر الدين (8) وهذا مع ذهابهم إلى عدم وجوب كون الامام أفضل الأمة (9)، بل جواز اشتباهه في الأحكام كما يشهد لذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال مكررا: لولا علي لهلك عمر.
وكيف كان فمعنى الإمامة عند العامة هي الخلافة الظاهرية مع أنها لو كانت واجدة لشرائطها لكانت شأنا من شؤون الإمامة عند الشيعة، فإن الإمامة عند الشيعة هي الخلافة الكلية الإلهية التي من آثارها ولايتهم التشريعية التي منها الإمارة والخلافة الظاهرية، لأن ارتقاء الإمام إلى المقامات الإلهية المعنوية يوجب أن يكون زعيما سياسيا لإدارة المجتمع الإسلامي أيضا، فالإمام هو الإنسان الكامل الإلهي العالم بجميع ما يحتاج إليه الناس في تعيين مصالحهم ومضارهم، الأمين على أحكام الله تعالى وأسراره، المعصوم من الذنوب والخطايا، المرتبط بالمبدأ الأعلى، الصراط المستقيم، الحجة على عباده، المفترض طاعته، اللائق لاقتداء العام به والتبعية له، الحافظ لدين الله، المرجع العلمي لحل المعضلات والاختلافات وتفسير المجملات، الزعيم السياسي والاجتماعي، الهادي للنفوس إلى درجاتها اللائقة بهم من الكمالات المعنوية، الوسيط في نيل الفيض من المبدأ الأعلى إلى الخلق، وغير ذلك من شؤون الإمامة التي تدل عليها البراهين العقلية والأدلة السمعية وستأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله تعالى.
وينقدح من ذلك أن ما ذكره جماعة من علماء الإمامية تبعا لعلماء العامة في تعريف الإمامة من أنها رياسة عامة في أمور الدين والدنيا ليس تعريفا جامعا للإمامة وإنما هو إن تم شأن من شؤون الإمامة ولعل علماءنا ذكروه في قبال العامة من باب المماشاة، وإلا فمن المعلوم أن هذا التعريف ليس إلا تعريفا لبعض الشؤون التشريعية للإمام، وهو الزعامة السياسية والاجتماعية ولا يشمل سائر المقامات المعنوية الثابتة للإمام كما أشرنا إليه في تعريف الإمام، والعجب من المحقق اللاهيجي - قدس سره - حيث ذهب إلى تطبيق التعريف المذكور على الإمامة عند الشيعة مستدلا بأن الرياسة في أمور الدين لا يتحقق إلا بمعرفة الأمور الدينية (10)، مع أن المعرفة بالأمور الدينية أعم من العلم الإلهي، ويصدق مع الاجتهاد في الأمور الدينية إن لم نقل بكفاية التقليد في جلها هذا، مضافا إلى خلوة عن اعتبار العصمة.
وكيف كان فالأمر سهل بعد ما عرفت من ماهية الإمامة عند الشيعة، فالاختلاف بيننا وبين العامة اختلاف جوهري لا في بعض الشرائط، ولذلك قال الأستاذ الشهيد المطهري - قدس سره -: لزم علينا أن لا نخالط مسألة الإمامة مع مسألة الحكومة ونقول: إن العامة ماذا تقول؟ ونحن ماذا نقول؟ بل مسألة الإمامة مسألة أخرى، ومفهوم نظير مفهوم النبوة بما لها من درجاتها العالية، وعليه فنحن معاشر الشيعة نقول بالإمامة، والعامة لا تقول بها أصلا، لا أنهم قائلون بها، ولكن اشترطوا فيها شرائط أخرى (11).
ثم لا يخفى عليك أن الإمامة بالمعنى المختار والنبوة قد يجتمعان كما في إبراهيم الخليل - عليه السلام - كما نص عليه في قوله بعد مضي مدة من الزمن لنبوة: " إني جاعلك للناس إماما " (12) بل في عدة أخرى من الأنبياء كما يشهد له قوله تعالى: " وجعلنا هم أئمة يهدون بأمرنا " (13) ولا سيما نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وقد يفترقان إذ بعض الأنبياء كانوا يأخذون الوحي ويبلغونه إلى الناس وأطاع عنهم من أطاع فيما بلغ إليهم، ولكن مع ذلك لم يكونوا نائلين مقام الإمامة، واقتداء الخلق بهم وقيادة الناس، وسوقهم نحو السعادة والكمال، كما أن أئمتنا - عليهم السلام - كانوا نائلين مقام الإمامة، ولكن لم يكونوا أنبياء فالنسبة بين الإمامة والنبوة عموم من وجه (14). ثم إن المقصود من البحث في الإمامة حيث كان هو الإمام الذي يكون خليفة عن النبي قيدت الإمامة في التعاريف بالنيابة عن النبي - صلى الله عليه وآله - كما يظهر من تعاريف القوم، بل أصحابنا ومنهم العلامة - قدس سره - حيث عرفوها بأنها رياسة عامة في أمور الدنيا والدين لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي، وعليه فيصدق على كل واحد من أئمتنا عنوان الإمام وعنوان خليفة الرسول أو وصي الرسول، كما يصدق عليه عنوان خليفة الله أيضا ولا مانع من اجتماع هذه العناوين فيه كما لا يخفى.
المقام الثالث: في شؤون الإمامة ومنزلتها: ولا يخفى عليك أن الإمام حيث كان خليفة الله في أرضه فليكن مظهر أسمائه وصفاته، كما أنه يتصف بصفات النبي أيضا، لكونه خليفة له فإن كان النبي معصوما فهو أيضا معصوم، وإن كان النبي عالما بالكتاب والأحكام والآداب فهو أيضا عالم بهما، وإن كان النبي عالما بالحكمة فهو أيضا عالم بها وإن كانا لنبي عالما بما كان وما يكون فهو أيضا عالم به، وهكذا فالإمام يقوم مقام النبي في جميع صفاته عدا كونه نبيا.
وبالجملة فالأئمة هم ولاة أمر الله، وخزنة علم الله، وعيبة وحي الله، وهداة من بعد النبي، وتراجمة وحي الله، والحجج البالغة على الخلق، وخلفاء الله في أرضه، وأبواب الله عز وجل التي يؤتى منها، و... فهذه منزلة عظيمة لا ينالها الناس بعقولهم أو بآرائهم.
ثم إن أحسن رواية في تبيين هذه المنزلة هو ما نص عليه مولانا علي بن موسى الرضا - عليهما السلام - حيث قال:...
إن الإمامة أجل قدرا، وأعظم شأنا، وأعلا مكانا، وأمنع جانبا، وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم أن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل - عليه السلام - بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد (15) بها ذكره فقال: " إني جاعلك للناس إماما " فقال الخليل - عليه السلام - سرورا بها: " ومن ذريتي " قال الله تبارك وتعالى: " لا ينال عهدي الظالمين " فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال: " ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين " (16) فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله تعالى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال جل وتعالى: " إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين " (17) فكانت له خاصة فقلدها - صلى الله عليه وآله - عليا - عليه السلام - بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعالى: " وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث " (18) فهي في ولد علي - عليه السلام - خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد - صلى الله عليه وآله - فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟!
إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وارث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله، وخلافة الرسول، ومقام أمير المؤمنين - عليه السلام وميراث الحسن والحسين - عليهما السلام - إن الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي، وفرعه السامي (19)، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وتوفير الفئ والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف، الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله، ويدعوا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحجة البالغة، الإمام كالشمس الطالعة المجللة (20) بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، الإمام البدر المنير، والسراج الزاهر (21)، والنور الساطع، والنجم الهادي في غياهب الدجى (22)، وإجواز (23) البلدان والقفار، ولجج (24) البحار، الإمام الماء العذب على الظمأ، والدال على الهدى، والمنجي من الردى، الإمام النار على اليفاع (25)، الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك، من فارقه فهالك، الإمام السحاب الماطر، والغيث الهاطل (26)، والشمس المضيئة، والسماء الظليلة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرة (27)، والغدير والروضة، الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق (28) والأخ الشقيق (29)، والام البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآد (30)، الإمام أمين الله في خلقه، وحجته على عباده، وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله، والذاب عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب، والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين، وعز المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين، الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل فمن ذا الذي يبلغ معرفة الامام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم (31)، وحارت الألباب، وخسئت العيون، وتصاغرت العظماء، وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء، وحصرت الخطباء، وجهلت الألباء، وكلت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعييت (32) البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله، أو ينعت بكنه، أو يفهم شئ من أمره، أو يوجد من يقوم مقامه، ويغني غناه، لا كيف وأني وهو بحيث النجم من يد المتناولين، ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا، وأين العقول عن هذا، وأين يوجد مثل هذا؟ - إلى أن قال -: والقرآن يناديهم: " وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون " (33) - إلى أن قال -: فكيف لهم باختيار الإمام؟ والإمام عالم لا يجهل، وراع لا ينكل (34)، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول ونسل المطهرة البتول، لا مغمز (35) فيه في نسب، ولا يدانيه ذو حسب (36)، فالبيت من قريش والذروة (37) من هاشم والعترة من الرسول - صلى الله عليه وآله والرضا من الله عز وجل، شرف الإشراف، والفرع (38) من عبد مناف نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع (39) بالإمامة عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عز وجل، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله، إن الأنبياء والأئمة - صلوات الله عليهم - يوفقهم الله، ويؤتيهم من مخزون علمه، وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى: " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكن كيف تحكمون " (40) - إلى أن قال -: فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك، ليكون حجته (البالغة) على عباده، وشاهده على خلقه " وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم " فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه؟. أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه... الحديث (41).
المقام الرابع: في أنها أصل من أصول الدين أو فرع من فروعه، وقد عرفت مما ذكرنا أن الإمامة هي الخلافة الإلهية التي تكون متممة لوظائف النبي وإدامتها عدا الوحي، فكل وظيفته من وظائف الرسول من هداية البشر وإرشادهم وسوقهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في الدارين وتدبير شؤونهم، وإقامة العدل، ورفع الظلم والعدوان، وحفظ الشرع، وبيان الكتاب، ورفع الاختلاف، وتزكية الناس، وتربيتهم، وغير ذلك ثابتة للإمام وعليه فما أوجب إدراج النبوة في أصول الدين أوجب إدراج الإمامة بالمعنى المذكور فيها، وإلا فلا وجه لإدراج النبوة فيها أيضا. قال في دلائل الصدق: ويشهد لكون الإمامة من أصول الدين أن منزلة الامام كالنبي في حفظ الشرع ووجوب اتباعه والحاجة إليه ورياسته العامة بلا فرق، وقد وافقنا على أنها أصل من أصول الدين جماعة من مخالفينا كالقاضي البيضاوي في مبحث الاخبار، وجمع من شارحي كلامه، كما حكاه عنهم السيد السعيد رحمه الله (42).
نعم لو كانت الإمامة بمعنى خصوص الزعامة الاجتماعية والسياسية، فالانصاف أنها من فروع الدين كسائر الواجبات الشرعية من الصوم والصلاة وغيرها، لا من أصولها، فما ذهب إليه جماعة من المخالفين من كون الإمامة من أصول الدين مع ذهابهم إلى أن الإمامة بمعنى الزعامة الاجتماعية والسياسية منظور فيه.
وإليه أشار الأستاذ الشهيد المطهري - قدس سره - حيث قال: إن كانت مسألة الإمامة في هذا الحد يعني الزعامة السياسية للمسلمين بعد النبي - صلى الله عليه وآله - فالانصاف أنا معاشر الشيعة جعلنا الإمامة من أجزاء فروع الدين لا أصوله ونقول: إن هذه المسألة مسألة فرعية كالصلاة، ولكن الشيعة التي تقول بالإمامة لا يكتفون في معنى الإمامة بهذا الحد (43).
ثم إنه يمكن الاستدلال لذلك مضافا إلى ما ذكر بقوله تعالى: " يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته " (44) فإن الآية بعد كونها نازلة في الإمامة والولاية عند أواخر حياة الرسول - صلى الله عليه وآله - دلت على أنها أصل من أصول الدين، إذ الإمامة على ما تدل عليه الآية المباركة أمر لو لم يكن كان كأن لم يكن شئ من الرسالة والنبوة فهذه تنادي بأعلى صوت أن الإمامة من الاجزاء الرئيسية الحياتية للرسالة والنبوة فكيف لا تكون من أصول الدين وأساسه؟
وأيضا يمكن الاستدلال بقوله تعالى في سورة المائدة التي تكون آخر سورة نزلت على النبي - صلى الله عليه وآله -: " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا " (45) فإن الآية كما نصت عليه الروايات نزلت في الإمامة والولاية لعلي - عليه السلام - - ويؤيده عدم صلاحية شئ آخر عند نزولها لهذا التأكيد فالآية جعلت الإمامة مكملة للدين ومتممة للنعمة، فما يكون من مكملات الدين ومتمماته كيف لا يكون من أصول الدين وأساسه؟
هذا مضافا إلى النبوي المستفيض عن الفريقين أنه قال رسول - صلى الله عليه وآله -: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية (46)، وهذا الحديث يدل على أن معرفة الامام إن حصلت ثبت الدين، وإلا فلا دين له إلا دين جاهلي.
وفي خبر آخر عن رسول الله - صلى الله عليه وآله -: من مات ولم يعرف إمام زمانه فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا (47). وهو يدل على أن معرفة الإمامة إن حصلت ثبت الاسلام وإلا فلا اسلام له، وكيف كان فإذا كان مفاد الحديث أن معرفة الإمامة من مقومات الدين أو الاسلام فكيف لا تكون داخلة في أصول الدين وأساسه (48)؟ هذا مع الغمض عن الأحاديث الكثيرة المروية في جوامعنا التي تؤيد هذا المضمون فراجع (49).
ولقد أفاد وأجاد المحقق اللاهيجي - قدس سره - بعد نقل كلام شارح المقاصد الذي قال: إن مباحث الإمامة أليق بعلم الفروع، حيث قال: إن جمهور الامامية اعتقدوا بأن الإمامة من أصول الدين لأنهم علموا أن بقاء الدين والشريعة موقوف على وجود الامام كما أن حدوث الشريعة موقوف على وجود النبي فحاجة الدين إلى الامام بمنزلة حاجته إلى النبي (50).
فإذا ثبت أن الإمامة أصل من أصول الدين فاللازم فيه هو تحصيل العلم، ولا يكفي فيه التقليد الذي لا يفيد إلا الظن لما عرفت من أن احتمال الضرر لا يدفع بسلوك الطريق الظني كما لا يخفي.
ثم إن معنى كون الإمامة من الأصول هو وجوب الاعتقاد والتدين بوجود الامام المنصوب من الله تعالى في كل عصر بعد النبي وخاتميته، كما أن معنى كونها من الفروع هو وجوب نصب أحد للرياسة والزعامة والانقياد له، فيما إذا لم ينصبه بعد النبي - صلى الله عليه وآله - فيقع الكلام في كيفية النصب المذكور أنه باختيار بعض آحاد الأمة، أو باختيار جميعهم، أو باختيار أكثرهم، أو غير ذلك؟
وأما بناء على كونها من الأصول فلا يبقي لهذا الكلام مجال، كما لا مجال له في وجود النبي كما لا يخفى، ثم إن الإمامة - إذا كانت الإمامة أصلا من أصول الدين - يلزم من فقدها اختلال الدين، ولكن مقتضى الأدلة التعبدية هو كفاية الشهادتين في إجراء الاحكام الاسلامية في المجتمع الاسلامي، في ظاهر الحال، ولا منافاة بينهما فلا تغفل (51).
ولما ذكر يظهر وجه تسمية الإمامة والعدل بأصول المذهب فإن معناه بعد ما عرفت من كفاية الشهادتين تعبدا في ترتب أحكام الاسلام أن إنكارهما يوجب الخروج عن مذهب الإمامية لا عن إجراء الاحكام الاسلامية .
المقام الخامس : في وجوب النظر في إمامة أئمتنا - عليهم السلام - : ولا ريب في ذلك بناء على كونها أصلا من أصول الدين ، فيجب النظر فيها عقلا كسائر آحاد أصول الدين بملاك واحد ، كما مر في أول الشرح من وجوب دفع الضرر المحتمل ، ووجوب شكر المنعم .
وأما بناء على عدم كونها أصلا من أصول الدين كما ذهب إليه أكثر العامة فعلى الأقل تكون الإمامة قابلة للنظر والبحث بعنوان المرجعية العلمية الإلهية ، لامكان تعيين أشخاص من ناحيته تعالى لبيان الاحكام وحفظها ، فمع هذا الاحتمال يجب بحكم العقل الفحص والنظر فيه ، فإن ثبتت تلك المرجعية لآحاد من الأمة فلا يعلم بفراغ الذمة من التكاليف الشرعية إلا بمراجعتهم وأخذ الاحكام منهم ، لأنهم حجة في بيان الاحكام لا غيرهم ، فالعقل يحكم بوجوب القطع بفراغ الذمة من التكاليف الشرعية دفعا للضرر المحتمل ، وهو
لا يحصل إلا بالرجوع إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه ، فالبحث والنظر عمن نكون مأمورين باتباعه واجب عقلي .
ونحن ندعي ونعتقد أن الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام - بعد نبينا محمد - صلى الله عليه وآله - هم خلفاء الله في أرضه وأمناؤه على أحكام ، فلو لم تثبت ولايتهم المعنوية وزعامتهم السياسية والاجتماعية لاخواننا المسلمين ، فلم لم يتفحصوا ولم ينظروا حتى يأخذوا بآثارهم مع أن مرجعيتهم العلمية ثابتة بالروايات المتواترة بين الفريقين .
منها : الحديث المعروف بحديث الثقلين المجمع عليه بين الفريقين ، المروي في الكتب المعتبرة عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال في مواضع متعددة وحتى في الخطبة الأخيرة منه: " أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما لن تضلوا فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " (52) فكما أن القرآن بنص الحديث حجة، كذلك العترة فآراؤهم وأقوالهم حجة بنفسها، فعلى إخواننا المسلمين الفحص والنظر عن المرجعية العلمية للأئمة الاثني عشر التي اعتقد بها الشيعة، ولا يجوز بحكم العقل عدم التوجه إلى هذه المرجعية على الأقل، إذ مع احتمالها لا يكفي في الامتثال العمل بغير طريقة الأئمة - عليهم السلام - كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى أن أئمتنا - عليهم السلام - هم الذين كانوا وارثين لعلم الرسول ومخزن علمه فعلى إخواننا المسلمين أن يأخذوا وظائفهم الشرعية عن طريق أئمتنا - عليهم السلام - ولقد أفاد وأجاد السيد المحقق المتتبع المرجع الديني آية الله العظمى البروجردي - قدس سره - حيث قال في مقدمة جامع أحاديث الشيعة - بعد نقل روايات تدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أملى كل حلال وحرام لعلي - عليه السلام - فكتبه بيده وبقي عند الأئمة - عليهم السلام: وقد يظهر من هذه الأحاديث أمور:
الأول: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يترك الأمة بعده سدى مهملة بلا إمام هاد وبيان شاف، بل عين لهم أئمة هداة دعاة سادة قادة حفاظا، وبين لهم المعارف الإلهية والفرائض الدينية، والسنن والآداب، والحلال والحرام، والحكم والآثار، وجميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش، ولم يأذن - صلى الله عليه وآله - لاحد أن يحكم أو يفتي بالرأي والنظر والقياس، لعدم كون موضوع من الموضوعات أو أمر من الأمور خاليا عن الحكم الثابت له من قبل الله الحكيم العليم ، بل أملى - صلى الله عليه وآله - جميع الشرايع والاحكام على الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام - وأمره بكتابته وحفظه ورده إلى الأئمة من ولده - عليهم السلام - فكتبه - عليه السلام - بخطه وأداه إلى أهله .
والثاني : أنه - صلى الله عليه وآله - أملى هذا العلم على علي بن أبي طالب - عليه السلام - فقط ، ولم يطلع عليه في عصره - صلى الله عليه وآله غيره أحد ، وأوصى إليه أن يكون هذا الكتاب بعده عند الأئمة الأحد عشر ، فيجب على الأمة كلهم أن يأخذوا علم الحلال والحرام ، وجميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - من علي بن أبي طالب والأئمة من ولده - عليهم السلام - فإنهم موضع سر النبي - صلى الله عليه وآله - وخزان علمه وحفاظ دينه .
والثالث : أن الكتاب كان موجود عند الأئمة - عليهم السلام – وأراه الامامان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابنه أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - عليهم السلام - جماعة من أصحابنا الإمامية وغيرهم من الجمهور ، لحصول الاطمئنان ، أو الاحتجاج على ما كانا يتفردان من الفتاوى عن سائر الفقهاء ، ويقسمان بالله أنه إملاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب – عليه السلام - .
والرابع : كون الكتاب معروفا عند الخاصة والعامة في عهد الامامين – عليهما السلام - لأنهما كثيرا ما يقولان في جواب استفتاءات الجمهور - كغياث بن إبراهيم وطلحة بن زيد والسكوني وسفيان بن عيينة والحكم بن عتيبة ويحيى بن سعيد وأمثالهم - أن في كتاب علي - عليه السلام - كذا وكذا في جواب مسائل الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم وعبد الله بن سنان وأبي حمزة وابن بكير وعنبسة بن بجاد العابد ونظائرهم .
والخامس: أن ما عند الأئمة - عليهم السلام - من علم الحلال والحرام والشرائع والأحكام نزل به جبرئيل - عليه السلام - وأخذوه من رسول الله - صلى الله عليه وآله - فتحرم على الأمة مخالفتهم في الحكم والفتوى اعتمادا على الرأي والقياس والاجتهاد، ويجب عليهم الاخذ بأحاديثهم وفتاويهم، ورد ما يرد عن مخالفيهم، لان ما عندهم أوثق مما عند غيرهم، ومعلوم أن ما ورد في كون أحاديث الأئمة الاثني عشر وعلومهم - عليهم السلام - عن النبي - صلى الله عليه وآله - من طرق العامة والخاصة قد تجاوزت حد التواتر، بل لا يسعها المجلدات الضخام ولسنا بصدد استقصائها في هذا الكتاب (53)، فما قاله أئمتنا - عليهم السلام - قاله النبي - صلى الله عليه وآله - فيجب الاتباع عنهم كما يجب الاتباع عن النبي - صلى الله عليه وآله -
المقام السادس: في كون الإمامة لطفا ورحمة، ولا سترة فيه: بعد ما عرفت من شؤون الإمامة فإن شؤون الإمامة عين شؤون نبوة نبينا عدا الوحي، فكما أن النبوة لطف ورحمة كذلك الإمامة.
قال الحكيم المتأله المولى محمد مهدي النراقي: إن رتبة الإمامة قريب برتبة النبوة إلا أن النبي مؤسس للتكاليف الشرعية بمعنى أنه جاء بالشريعة والاحكام والأوامر والنواهي من جانبه تعالى ابتداء، والامام يحفظها ويبقيها بعنوان النيابة عن النبي - صلى الله عليه وآله - (54).
ثم إن في الإمامة كالنبوة مراتب من اللطف والرحمة التي تقتضيها رحيميته تعالى، وكماله المطلق، فأصل وجود الامام لطف فإنه إنسان كامل كما أن تصرفه في الناس بهدايتهم وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة، وتدبير شؤونهم ومصالحهم، وإقامة العدل ورفع الظلم والعدوان من بينهم، وتزكيتهم وحفظ الشريعة عن التحريف والزيادة والنقصان، وإزالة الشبهات، وتفسير الكتاب، وتبيين المشتبهات، وغير ذلك ألطاف اخر، التي يقتضيها كماله المطلق ورحيميته المطلقة، ومن تلك المراتب الهداية الايصالية.
قال العلامة الطباطبائي - قدس سره -: إن الامام هاد يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه، فالامامة بحسب الباطن نحو ولاية للناس في أعمالهم، وهدايتها إيصالها إياهم إلى المطلوب بأمر الله، دون مجرد إرائة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول (55)، ولذا قال في ذيل قوله تعالى: " وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا " (56):
إن الهداية المجعولة من شؤون الإمامة ليست هي بمعنى إرائة الطريق، لان الله سبحانه جعل إبراهيم إماما بعد ما جعله نبيا كما أوضحناه في تفسير قوله: " إني جاعلك للناس إماما " فيما تقدم ولا تنفك النبوة عن الهداية بمعنى إرائة الطريق، فلا يبقى للإمامة إلا الهداية بمعنى الايصال إلى المطلوب، وهي نوع تصرف تكويني في النفوس بتسييرها في سير الكمال ونقلها من موقف معنوي إلى موقف آخر. وإذا كانت تصرفا تكوينيا وعملا باطنيا فالمراد بالامر الذي تكون به الهداية ليس هو الامر التشريعي الاعتباري، بل ما يفسره في قوله: " إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون * فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ " (57) فهو الفيوضات المعنوية والمقامات الباطنية التي يهتدي إليها المؤمنون بأعمالهم الصالحة ويتلبسون بها رحمة من ربهم وإذ كان الامام يهدي بالامر - والباء للسببية أو الآلة - فهو متلبس به أولا ومنه ينتشر في الناس على اختلاف مقاماتهم، فالامام هو الرابط بين الناس وبين ربهم في إعطاء الفيوضات الباطنية وأخذها، كما أن النبي رابط بين الناس وبين ربهم في أخذ الفيوضات الظاهرية، وهي الشرايع الإلهية تنزل بالوحي على النبي وتنتشر منه، وبتوسطه إلى الناس وفيهم، والامام دليل هاد للنفوس إلى مقاماتها كما أن النبي دليل يهدي الناس إلى الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة (58)، ثم إن ما ذكره العلامة الطباطبائي - قدس سره - يكون في مقام الفرق بين الامام والنبي فلا ينافي ما أشرنا إليه من اجتماع وظائف النبي - صلى الله عليه وآله - عدا تلقي الوحي في الامام مع وظائفه، كما عرفت من أن أئمتنا - عليهم السلام - يقومون مقام النبي - صلى الله عليه وآله - في وظائفه وعليه فلا تنحصر وظائفهم في الهداية المعنوية كما لا يخفي.
وكيف كان فالامامة كالنبوة لطف مضاعف فإنها لطف في لطف من دون فرق بين كونه ممكنا أو مقربا أو أصلح، ومما ذكر يظهر ما في اقتصارهم على الزعامة السياسية في مقام بيان إثبات كون الإمامة لطفا كما في شرح تجريد الاعتقاد وشرح الباب الحادي عشر (59)، مع أنها شأن من شؤون الإمامة وشطر منها، كما يظهر أيضا مما ذكر، ما في اكتفاء بعض آخر على ذكر فائدة حفظ الشريعة الواصلة عن النبي - صلى الله عليه وآله - عن التحريف والتغير في مقام بيان فوائد وجود الامام مع أنه نوع من أنواع لطف وجود الامام فلا تغفل.
المقام السابع: في لزوم الإمامة: وقد عرفت أن الإمامة بالمعنى الذي لها عند الشيعة هي كالنبوة فكما أن النبوة لطف ورحمة، كذلك الإمامة فإذا ظهر كونها لطفا، والمفروض أنه لا يقترن بمانع يمنع عنه، فهو مقتضى علمه تعالى بالنظام الأحسن وإطلاق كماله وحكمته تعالى، وعليه فيصدر عنه تعالى، وإلا لزم أن يكون جاهلا بالنظام الأحسن، أو لزم عدم كونه تعالى كمالا مطلقا وحكيما، وهو خلف في كونه عليما ورحيما وحكيما بالأدلة والبراهين القطعية، وإليه يؤول ما يقال في تقريب لزوم الإمامة أنها واجب في حكمته تعالى، لان المراد من الوجوب هو اللزوم والمقتضي كما مر مرارا، لا الوجوب عليه فالأولى هو التعبير بالاقتضاء واللزوم كما عبر عنه الشيخ أبو علي سينا في الشفاء حيث قال في مقام إثبات النبوة بعد ذكر المنافع التي لا دخل لها في بقاء النوع الانساني، كإثبات الشعر في الحاجب والأشفار: فلا يجوز أن يكون العناية الأولى تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هو أسها (60).
وهذا كله بناء على التقريب الفلسفي الذي ذهب إليه المصنف في إثبات النبوة والإمامة، وحاصله: أن النبوة والإمامة كليهما مما يقتضيهما كماله المطلق ورحيميته المطلقة وإلا لزم الخلف في كونه كمالا مطلقا كما لا يخفي، وأما بناء على التقريب الكلامي فتقريبه كالتقريب الذي مضى في النبوة وهو أن يقال:
إن ترك اللطف نقض الغرض، لان غرض الحكيم لا يتعلق إلا بالراجح وهو وجود الانسان الكامل وإعداد الناس وتقريبهم نحو الكمال، وهو لا يحصل بدون الامام، فيجب عليه اللطف، لان ترك الراجح عن الحكيم المتعال قبيح بل محال، إذ مرجع الترجيح من غير مرجح إلى الترجح من غير مرجح كما لا يخفى.
وكيف كان فلا بد في كل عصر من وجود إمام هو يكون إنسانا كاملا هاديا للناس والخواص، مقيما للعدل والقسط، رافعا للظلم والعدوان، حافظا للكتاب والسنة، رافعا للاختلاف والشبهة، أسوة يتخلق بالأخلاق الحسنة حجة على لجن والانس، وإلا كما عرفت لزم الخلف في كمال ذاته وهو محال، أو الاخلال بغرضه وهو قبيح عن الحكيم، بل هو أيضا محال كما عرفت، فإذا كان كل نوع من أنواع لطف وجود الامام من أغراضه تعالى فلا وجه.
لتخصيص نقض الغرض بنوع منها كما يظهر من بعض الكتب الكلامية، مع أن كل نوع منها راجح من دون اقتران مانع، فبترك كل واحد يوجب نقض الغرض، ولعل الاكتفاء ببعض الأنواع، من باب المثال فافهم. فالأولى هو عدم التخصيص ببعض تلك الأنواع، ولعل إليه يؤول ما في متن تجريد الاعتقاد حيث قال: الامام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض (61).
ثم إن مقتضى كون وجود الامام كالنبي لطفا مضاعفا ان كل واحد من أبعاد وجوده وفوائده يكون كافيا في لزوم وجوده، فإن طرأ مانع عن تحقق بعضها كالتصرف الظاهري بين الناس يكفي الباقي في لزوم وجوده وبقائه.
وينقدح مما ذكر أن ظهور الإمام للناس لطف زائد على وجوده الذي يقتضيه علمه تعالى بالنظام الأحسن وإطلاق كماله، فإرشاده وتعليمه وتزكيته للناس لطف آخر، وهكذا بقية الشؤون التي تكون للامام.
هذا مضافا إلى أن إرشاده وتعليمه وتزكيته للجن أيضا لطف في حقهم فإنهم مكلفون ومحجوجون بالحجج الإلهية كما لا يخفى.
ثم بعد وضوح أن الإمامة كالنبوة اتضح لك أنها أمر فوق قدرة البشر، فلا تنالها يده ولا يمكن له تعيينها واختيارها، بل هي فعل من أفعاله تعالى فيجعلها حيث يشاء وهو أعلم بمن يشاء ومنه يظهر أنه لا مجال للبحث عن وجوب نصب الإمام على الناس وكيفيته، فإن ذلك من فروع الامارة الظاهرية مع عدم تعيين الخليفة الإلهية عن الله تعالى.
وأما مع تعيينها فلا مجال للبحث عنه إذ المعلوم أن الامارة له، كما أنه لا بحث مع وجود النبي المرسل عن وجوب نصب الأمير على الناس، لان الامارة من شؤون النبي المرسل كما لا يخفى.
الإمام الثاني عشر - أرواحنا فداه - وتصرفه فائدة من فوائد وجوده، لان فوائد وجوده كثيرة وإن كان غائبا، الأول: أنه قد ورد في الحديث القدسي عنه تعالى أنه قال: " كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف " (62) فيعلم منه أن الباعث على ايجاد الانسان هو المعرفة بالله تعالى، فليكن في كل وقت فرد بين آحاد الانسان يعرفه كما هو حقه، ولا تحصل المعرفة كما هو حقه في غير النبي والامام، فلابد من وجود الحجة في الأرض حتى تحصل المعرفة به كما هو حقه بين الناس.
والثاني: أن مجرد وجوده لطف وفيض في حق الناس ولو لم يكن ظاهرا، لان وجوده باعث نزول البركات والخيرات، ومقتض لدفع البليات والآفات، وسبب لقلة سلطة الشياطين من الجن والإنس على البلاد، فإن آثار الشيطان كما وصلت إلى البشر دائما كذلك لزم أن تصل آثار رئيس الموحدين وهو الحجة الإلهية إليهم، فوجود الحجة في مقابل الشيطان للمقاومة مع جنوده، فلو لم يكن للامام وجود في الأرض صارت سلطة الشيطان أزيد من سلطة الأولياء، فلا يمكن للانسان المقاومة في مقابل جنود الشيطان.
والثالث: أن غيبة الإمام الثاني عشر - أرواحنا فداه - تكون عن أكثر الناس، لا عن جميعهم، لوجود جمع يتشرفون بخدمته، ويأخذون جواب الغوامض من المسائل ويهتدون بهدايته، وإن لم يعرفوه. انتهى ملخص كلامه (63).
سؤال: وهو أن الامام يجب وجوده لو لم يقم لطف آخر مقامه كعصمة جميع الناس.
والجواب عنه واضح، لأن المفروض عدم إقامة هذا اللطف، وإلا فلا موجب لبعث الرسل والأنبياء أيضا كما لا يخفى فوجود الامام كوجود النبي واجب فيما إذا لم يكن الناس معصومين كما هو المفروض.
سؤال: وهو أن الامام يجب وجوده فيما إذا علم بخلوه عن المفسدة، وحيث لا علم به فلا يكون وجود الامام واجبا، ولا فائدة في دعوى عدم العلم بالمفسدة، لان احتمالها قادح في وجوب نصب الإمام كما لا يخفى.
وأجاب عنه المحقق اللاهيجي - قدس سره -: بأن الأمور المتعلقة بالامام على قسمين: الدنيوية والأخروية ومن المعلوم أن مفسدة وجود الامام بالنسبة إلى الأمور الدينية معلومة الانتفاء، فإن المفاسد الشرعية في الأمور الدينية معلومة شرعا، ولا يترتب شئ منها على وجود الامام، وهذا ضروري عند العارف بالمفاسد الشرعية، وحيث كان كل واحد منا مكلفون بترك المفاسد الشرعية، فلا يجوز أن لا تكون تلك المفاسد معلومة لنا، وإلا لزم التكليف بالمجهول وهو كما ترى.
وأيضا من الواضح أن نصب الإمام بالنسبة إلى الأمور الدنيوية لا مفسدة فيه إذ الأمور الدنيوية راجعة إلى مصالح العباد ومفاسدهم في حياتهم الدنيوية وحفظ النوع والاخلال به، وهي معلومة لكافة العقلاء، ولا يترتب من وجود الامام شئ من المفاسد فيها، بل العقل جازم بأن لا يمكن سد مفاسد أمور المعاش إلا بوجود سلطان قاهر عادل.
فإذا عرفت ذلك فنقول بطريق الشكل الأول نصب الإمام عن الله تعالى لطف خال عن المفاسد، وكل لطف خال عن المفاسد واجب على الله تعالى، فنصب الامام واجب عليه تعالى وهو المطلوب (64). وإلى ما ذكر من الشبهة والأجوبة عنها يشير قول المحقق الطوسي - في متن تجريد الاعتقاد -: والمفاسد معلومة الانتفاء وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لطف، وتصرفه لطف آخر، وعدمه منا (65) وبالجملة لا شبهة في الصغرى في المقام، كما لا شبهة في كبرى لزوم اللطف فيما إذا كان خاليا عن الموانع والمفاسد، وأما ما يتراءى من بعض الشبهات حول قاعدة اللطف في بعض المقامات كاستكشاف رأي المعصوم عقلا بقاعدة اللطف من الاجماع كما ذهب إليه الشيخ الطوسي - قدس سره - فهو من ناحية الصغرى لا من ناحية الكبرى، وقد أشار إليه المصنف - قدس سره - في أصول الفقه فراجع (66).
هذا كله بحسب الأدلة العقلية وأما الأدلة السمعية التي تدل على لزوم وجود الامام للناس فكثيرة جدا ولا بأس بالإشارة إلى جملة منها.
فمن الآيات: قوله تعالى: " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون " (67) بتقريب: أن الخليفة حيث لم تكن مقيدة بالإضافة إلى مخلوق معين مما يؤكد أن الانسان خليفة الجاعل لا غيره، كما هو الظاهر من نظيره كقول رئيس الدولة: إني جاعل في هيئة الدولة خليفة، فإن العرف يفهمون منه أن المقصود هو خليفة نفسه لا غيره.
هذا مضافا إلى أن المقام الذي كان مطلوبا للملائكة هو مقام الخلافة الإلهية لا مقام خلافتهم عن الماضين من المخلوقات الأرضية فالمراد هو جعل الانسان خليفة له تعالى.
وحيث لم يذكر جهة الخلافة، كانت الخلافة ظاهرة في كون الانسان خليفة له في مختلف الشؤون وكافة الأمور، كما أن عدم ذكر ما استخلف عليه الإمامة في إبراهيم غير النبوة، كما يشهد تأخر جعلها عنها فإن جعله إماما بعد الابتلاء بالكلمات ومن ابتلاءاته ذبح إسماعيل، مع أنه لم يولد له ولد إلا في حال شيخوخيته وفي هذا الحال قد مضت من نبوته سنوات متعددة، فجعل الإمامة بعد جعل النبوة ثم سألها إبراهيم - عليه السلام - لذريته فأجيب بأن هذا المقام لا يناله الظالمون منهم، فالامامة منزلة بلوغ الانسان إلى غاية مقامات الانسانية بحيث يليق بأن يكون مقتدى لمن سواه من المخلوقين، ويمكن له أن يهديهم بهدايته الايصالية نحو سعادتهم في الدارين. مضافا إلى هدايتهم بالهداية الارشادية، كما قال العلامة الطباطبائي - قدس سره - من أن الامام وظيفته هداية الناس في ملكوت أعمالهم بمعنى سوقهم إلى الله سبحانه بإرشادهم وإيرادهم درجات القرب من الله سبحانه، وإنزال كل ذي عمل منزله الذي يستدعيه عمله (68).
ثم إن سؤال إبراهيم هذا المقام لذريته شاهد على عظمة هذا المقام، وجواب الله تعالى عن محرومية بعض ذريته عنه بكونها عهد الله، وهو لا يناله الظالمين أيضا شاهد على عظمة تلك المنزلة، كما أن هذا الجواب ظاهر في بقاء هذا المقام في ذريته حيث أخرج من ذريته جميع الظالمين فقط وبقي الباقي تحت الإجابة كما لا يخفى، فالآية تدل على بقاء الإمامة في نسله إجمالا، كما يؤيده ما جاء في الرواية من أن المراد من قوله تعالى: " وجعلها كلمة باقية في عقبة " (69) هو بقاء الإمامة في نسل إبراهيم إلى يوم الدين، على ما حكي عن المجمع، ويؤيده الروايات المتعددة التي وردت في بقاء الإمامة في نسل الحسين - عليه السلام - إلى يوم القيامة مستشهدا بالآية المذكورة.
منها ما عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن قوله الله عز وجل: " وجعلها كلمة باقية في عقبه " (70) قال: هي: الإمامة جعلها الله عز وجل في عقب الحسين - عليه السلام - باقية إلى يوم القيامة " (71). ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله: " وجعلها كلمة باقية " راجع إلى معنى كلمة التوحيد المستفاد من قوله تعالى: " وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين " ولكن قال في تفسير الميزان: ان التأمل في الروايات يعطي أن بناءها على إرجاع الضمير في قوله: " جعلها " إلى الهداية المفهومة من قوله: " سيهدين "، وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: " إني جاعلك للناس إماما " أن الامام وظيفته هداية الناس في ملكوت أعمالهم، بمعنى سوقهم إلى الله سبحانه بإرشادهم وايرادهم درجات القرب من الله سبحانه وانزال كل ذي عمل منزله الذي يستدعيه عمله، وحقيقة الهداية من الله سبحانه، وتنسب إليه بالتبع أو بالعرض، وفعلية الهداية النازلة من الله إلى الناس تشمله أولا، ثم تفيض منه إلى غيره، فله أتم الهداية ولغيره ما هي دونها، وما ذكره إبراهيم - عليه السلام - في قوله: " فإنه سيهدين " هداية مطلقة تقبل الانطباق على أتم مراتب الهداية التي هي حظ الامام منها، فهي الإمامة وجعلها كلمة باقية في عقبه جعل الإمامة كذلك (72)، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات.
وأما الروايات فمتواترة، وهي على طوائف، فمنها: ما يدل على أن الأئمة إثنا عشر إلى يوم القيامة، كما عن صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وآله - عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليهم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش، وعن صحيح مسلم أيضا عن جابر أيضا أن هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة، وعن صحيح مسلم أيضا عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان، وعن مسند أحمد بن حنبل عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرأنا القرآن فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمان هل سألتم رسول الله - صلى الله عليه وآله - كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك، ثم قال: نعم ولقد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وآله فقال إثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل، ورواه ابن حجر في الصواعق وحسنه. ورواه البحراني بطرق عديدة من العامة والخاصة (راجع الباب العاشر والحادي عشر من غاية المرام).
قال العلامة الحلي - قدس سره -: والاخبار في ذلك أكثر من أن تحصى (73)، وكيف كان فالمراد من هذه الروايات حصر الإمامة الشرعية في اثني عشر من قريش ما دام الناس لا السلطة الظاهرية، ضرورة حصولها لغير قريش في أكثر الأوقات، فيكون قرينة على أن المراد منها حصر الخلفاء الشرعيين في اثني عشر إلى يوم القيامة، كما أن الخبر الأخير دال على أنهم خلفاء بالنص، لقوله - صلى الله عليه وآله - (74) كعدة نقباء بني إسرائيل فإن نقباءهم خلفاء بالنص لقوله تعالى: " ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا " (75) وبالجملة هذه النصوص تدل على عدم خلو الأمة الاسلامية عن الامام إلى يوم القيامة، وصرح بأنهم اثنا عشر.
ومنها: ما تدل على أنه لا تخلو الأرض عن الحجة كما رواه في الكافي عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: لا، قلت: يكون إمامان؟ قال: لا، إلا وأحدهما صامت، وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم.
وعن أبي إسحاق عمن يثق به من أصحاب أمير المؤمنين - عليه السلام - أن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: اللهم إنك إنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك.
وعن أبي حمزة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قال: والله ما ترك الله أرضا منذ قبض آدم إلا وفيها إمام يهتدي به إلى الله وهو حجته على عباده ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة لله على عباده.
وعن أبي حمزة أيضا قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت، وعن حمزة بن الطيار قال:
سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة (76).
فهذه الروايات واضحة الدلالة على أن الأرض لا تخلو عن حجة الله على خلقه من لدن خلقه آدم إلى يوم القيامة.
ومنها: الروايات الدالة على أن أئمتنا لولا هم لما خلق الخلق، كما رواه في غاية المرام عن طرق الخاصة عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - في ضمن حديث: أن محمدا وعليا - صلوات الله عليهما - كانا نورا بين يدي الله عز وجل قبل خلق الخلق بألفي عام وأن الملائكة لما رأت ذلك النور، رأت له أصلا قد تشعب منه شعاع لا مع، فقالت: إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله عز وجل إليهم هذا نور من نوري أصله نبوة وفرعه إمامة، أما النبوة فلمحمد عبدي ورسولي وأما الإمامة فلعلي حجتي ووليي، ولولاهما ما خلقت خلقي.
ومنها: الروايات الدالة على أن أئمتنا - عليه السلام - لولاهم لما عرف الله ولما عبد، كما رواه في غاية المرام عن طرق الخاصة عن موسى بن جعفر - عليهما السلام - في ضمن حديث قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد من نور اخترعه من نور عظمته وجلاله - إلى أن قال -: قسم ذلك النور شطرين فخلق من الشطر الأول محمدا، ومن الشطر الاخر علي بن أبي طالب، ولم يخلق من ذلك النور غيرهما، إلى أن قال -: ثم اقتبس من نور محمد فاطمة ابنته، كما اقتبس نور (77) من نوره واقتبس من نور فاطمة وعلي والحسن والحسين كاقتباس المصابيح، هم خلقوا من الأنوار وانتقلوا من ظهر إلى ظهر، ومن صلب إلى صلب، ومن رحم إلى رحم، في الطبقة العليا، من غير نجاسة، بل نقلا بعد نقل - إلى أن قال -: بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، لأنهم صفوة الصفوة، اصطفاهم لنفسه، وجعلهم خزان علمه، وبلغاء عنه إلى خلقه، أقامهم مقام نفسه، لأنه لا يرى ولا يدرك، ولا تعرف كيفية انيته، فهؤلاء الناطقون المبلغون عنه المتصرفون في أمره ونهيه، فيهم يظهر قوته، ومنهم ترى آياته ومعجزاته، وبهم ومنهم عرف عباده نفسه، وبهم يطاع أمره، ولولاهم ما عرف الله ولا يدري كيف يعبد الرحمان، فالله يجري أمره كيف يشاء فيما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ومنها: الروايات الدالة على ثبوت الامرين المذكورين لائمة - عليهم السلام - كما رواه في غاية المرام عن علي بن موسى الرضا - عليه السلام - عن آبائه عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال : ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني . قال علي - عليه السلام - : فقلت : يا رسول الله ، فأنت أفضل أم جبرئيل ؟ فقال : يا علي ، إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين وفضلني على جميع النبيين والمرسلين ، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك ، فإن الملائكة من خدامنا وخدام محبينا يا علي ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ) بولايتنا يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ، ولا الجنة ولا النار ، ولا السماء ، ولا
الأرض ، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة ، وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا ، وتسبيحه وتهليله وتقديسه ، لان أول ما خلق الله عز وجل أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده ، ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون ، وأنه منزه عن صفاتنا ، فسبحت الملائكة تسبيحنا ، ونزهته عن صفاتنا ، فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه ، فقالوا : لا إله إلا الله ، فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال وأنه عظيم المحلل ، فلما شاهدوا ما جعل الله لنا من العزة والقوة قلنا : لا حول ولا قوة إلا بالله " العلي العظيم " ، لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوة إلا بالله ، فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة ، قلنا : الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه ،
فقالت الملائكة : الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله تعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده - إلى أن قال - : لما عرج بي إلى السماء - إلى أن قال -: فنوديت: يا محمد ( إن ) أوصياءك المكتوبون على ساق العرش فنظرت - وأنا بين يدي ربي جل جلاله - إلى ساق العرش فرأيت اثني عشر نورا في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم مهدي أمتي. فقلت يا رب أهؤلاء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: يا محمد، هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحجتي بعدك علي بريتي وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك، وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني، ولأعلين بهم كلمتي، ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي، ولأملكنه مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخرن له الرياح ولأذللن له السحاب الصعاب، ولأرقينه في الأسباب، ولأنصرنه بجندي، ولأمدنه بملائكتي، حتى تعلو دعوتي، ويجمع الخلق على توحيدي، ثم لأديمن ملكه، ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة (78).
وغير ذلك من طوائف الاخبار فراجع جوامع الاخبار.
___________
(1) الأنبياء: 73.
(2) القصص: 41.
(3) البقرة: 124.
(4) دلائل الصدق: ج 2 ص 4 نقلا عن الفضل بن روزبهان الأشعري المعروف.
(5) گوهر مراد: ص 329.
(6) گوهر مراد: ص 329.
(7) اللوامع الإلهية: ص 258 - 259.
(8) دلائل الصدق: ج 2 ص 4 نقلا عن الفضل.
(9) سرمايه ايمان: ص 116 الطبع الجديد.
(10) راجع گوهر مراد: ص 329.
(11) امامت ورهبرى: ص 163.
(12) البقرة: 124.
(13) الأنبياء: 73.
(14) راجع: امامت ورهبرى: 28، شيعه در اسلام: ص 252.
(15) أي رفع بهذه ذكره.
(16) الأنبياء: 72.
(17) آل عمران: 68.
(18) الروم: 56.
(19) أي العالي.
(20) بكسر اللام أي المحيطة.
(21) أي المضي.
(22) الغياهب: جمع الغيهب وهو الظلمة الشديدة والدجى جمع الدجية وهي الظلمة، وعليه فالإضافة بيانية وقد يعبر بالدجية عن الليل، وعليه فليست الإضافة بيانية.
(23) الإجواز: جمع الجوز وهو وسط كل شئ.
(24) اللجج: جمع اللجة وهي معظم الماء.
(25) أي ما ارتفع من الأرض مثل الجبل.
(26) أي المتتابع.
(27) أي كثيرة الماء.
(28) الذي لا يريد بك إلا خيرا.
(29) الأخ من الأب والأم.
(30) الداهية: الأمر العظيم أو المصيبة والنآد كسحاب الداهية، وإنما وصفت الداهية به للمبالغة في عظمتها وشدتها.
(31) أي ضلت الحلوم أي العقول.
(32) بكسر الياء الأولى أي عجزت.
(33) القصص: 68.
(34) أي لا يمتنع ولا يضعف ولا يجبن.
(35) المغمز: اسم مكان من الغمز أي الطعن، ويأتي بمعنى العيب.
(36) الحسب الشرف بالإباء وما يعده الإنسان من مفاخره.
(37) بضم الذال أي أعلى الشئ.
(38) والفرع من كل قوم هو الشريف منهم والفرع من الرجل أول أولاده وهاشم أول أولاد عبد مناف وأشرفهم.
(39) أي قوي على حمل أثقال الإمامة.
(40) يونس: 35.
(41) الأصول من الكافي: ج 1 ص 198.
(42) دلائل الصدق: ج 2 ص 8.
(43) امامت ورهبرى: ص 50 - 51.
(44) المائدة: 67.
(45) المائدة 3.
(46) موسوعة الإمام المهدي: ص 9، دلائل الصدق: ج 2 ص 6، الغدير: ج 10 ص 359 - 360 ونحوه في مسند الإمام الكاظم: ج 1 ص 355 وغيرها من الجوامع.
(47) معرفت امام: ص 6 نقلا عن رسالة المسائل الخمسون للفخر الرازي المطبوعة في ضمن كتاب مجموعة الرسائل بمصر سنة 1328 وهذا الحديث مذكور في ص 384.
(48) راجع دلائل الصدق: ج 2 ص 40.
(49) امامت ورهبرى: ص 58 - 63، وإحقاق: ج 2 ص 294 - 300.
(50) گوهر مراد: ص 333.
(51) راجع المكاسب المحرمة للشيخ الأعظم الأنصاري: مسألة الغيبة ص 40 طبع تبريز.
(52) راجع جامع أحاديث الشيعة: ج 1 ص 29 الطبع الثاني نقلا عن ينابيع المودة ص 114 ط اسلامبول سنة 1301 وغيره.
(53) جامع أحاديث الشيعة: ج 1 ص 11 الطبع الثاني.
(54) أنيس الموحدين: ص 127.
(55) تفسير الميزان: ج 1 ص 275، شيعه در اسلام، ص 253 - 260.
(56) الأنبياء: 73.
(57) يس: 82 - 83.
(58) تفسير الميزان: ج 14 ص 333.
(59) راجع شرح تجريد الاعتقاد: ص 362 الطبع الحديث، شرح الباب الحادي عشر: ص 40 الطبع الحديث.
(60) الهيات الشفاء: ص 557.
(61) شرح تجريد الاعتقاد: ص 362 الطبع الحديث.
(62) مصابيح الأنوار: ج 2 ص 405.
(63) أنيس الموحدين: ص 132 - 134.
(64) سرمايه ايمان: ص 108، وشرح تجريد الاعتقاد: ص 362 الطبع الحديث.
(65) شرح تجريد الاعتقاد: ص 362 الطبع الحديث.
(66) أصول الفقه: ج 2 ص 108.
(67) البقرة: 30.
(68) تفسير الميزان: ج 18 ص 111.
(69) الزخرف: 28.
(70) الزخرف: 28.
(71) تفسير نور الثقلين: ج 4 ص 597 نقلا عن معاني الأخبار.
(72) تفسير الميزان: ج 18 ص 111.
(73) راجع دلائل الصدق: ج 2 ص 314 - 316.
(74) راجع امامت ورهبرى: ص 163 - 169.
(75) المائدة: 12.
(76) راجع الأصول من الكافي: ج 1 ص 178.
(77) ولعل الصحيح نوره فالمراد هو اقتباس نور محمد - صلى الله عليه وآله - من نور عظمة الله سبحانه وتعالى.
(78) غاية المرام: ج 1 ص 26 الطبع الثاني.
 الاكثر قراءة في الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها
الاكثر قراءة في الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











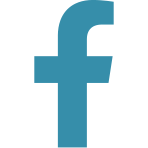

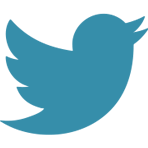

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)