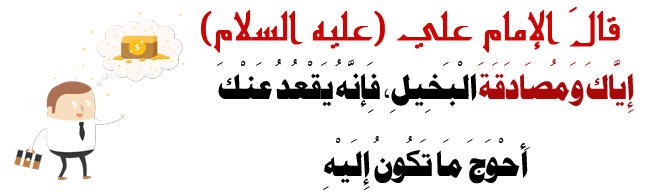
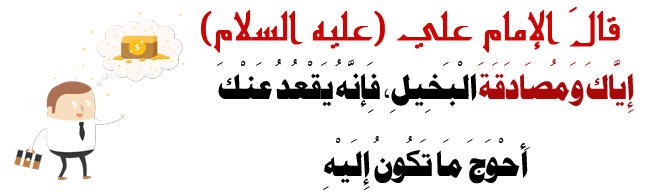

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2023
التاريخ: 2023-12-06
التاريخ: 17-10-2016
التاريخ: 18-1-2023
|
الأسماء: جمع اسم.
قال الجوهري: «الاسم مشتق من: سَموتُ؛ لأنّه تنويه ورفعة وتقدير، ووزنه: افعٌ، والذاهب منه الواو؛ لأن جمعه: أسماء، وتصغيره: سُمَيّ» (1).
وقال بعض الكوفيّين: «أصله وسم؛ لأنّه من الوسم وهو العلامة، فحذفت الواو وهي فاء الكلمة، وعوّض عنها الهمزة، فوزنه: اعل» (2). واستضعفه المحقّقون.
أقول: الاسم ما أنبأ عن المسمّىٰ، إن كان المسمّىٰ هو الذات لا بشرط شيء فهو اسم للذات، كلفظ الجلالة، فإنّه اسم الذات الواجب الوجود، المستجمع لجميع صفات الكمالات، من دون تعيين صفة من الصفات، وملاحظة تعيّن من التعيّنات معها.
أسماء الصّفات:
وإن كان المسمّىٰ هو الذات ولكن بشرط شيء، وبعبارة أخرى: ملحوظ بتعيّن من التعيّنات النوريّة، كالعلم والقدرة والحياة وغيرها فهو اسم الصفة، كالعلم والقادر والمريد والحي، إلىٰ آخر أسماء الصّفات.
بيان أقسام ثلاثة لأسماء الله تعالى:
عن بعض أهل التحقيق، قال: «الأسماء بالنسبة إلىٰ ذاته المقدّسة علىٰ ثلاثة أقسام:
الأول: ما يمنع إطلاقه عليه تعالى، وذلك كلّ اسم يدلّ علىٰ معنىً، يحيل العقل نسبته إلىٰ ذاته الشريفة، كالأسماء الدالّة علىٰ الاُمور الجسمانيّة، أو ما هو مشتمل علىٰ النقص والحاجة.
الثاني: ما يجوز عقلاً إطلاقه عليه تعالى وورد في الكتاب العزيز والسنّة الشريفة تسميته تعالى به، فذلك لا حرج في تسميته به، بل يجب امتثال الأمر الشرعي في كيفيّة إطلاقه، بحسب الأحوال والأوقات والتعبّدات، إمّا وجوباً، أو ندباً.
الثالث: ما يجوز إطلاقه عليه ولكن لم يرد ذلك في الكتاب والسنّة، كالجوهر، فإنّ أحد معانيه كون الشيء قائماً بذاته، غير مفتقر إلىٰ غيره، وهذا المعنى ثابت له تعالى، فيجوز تسميته به؛ إذ لا مانع في العقل من ذلك، لكنّه ليس من الأدب؛ لأنّه وإن كان جائزاً عقلاً ولم يمنع منه مانع، لكنّه جاز ألا يناسبه من جهة أخرى لا نعلمها، إذ العقل لم يطّلع علىٰ كافّة ما يمكن أن يكون معلوماً، فإنّ كثيراً من الأشياء لا نعلمها إجمالاً ولا تفصيلاً، وإذا جاز عدم المناسبة ولا ضرورة داعية إلىٰ التسمية، فيجب الامتناع من جميع ما لم يرد به نصّ شرعيّ من الأسماء.
وهذا معنى قول العلماء؛ «إنّ أسماء الله تعالى توقيفيّة»، يعني: موقوفة علىٰ النصّ والإذن في الإطلاق.
بيان أقسام أربعة لأسمائه تعالى:
إذا تقرّر هذا، فاعلم أنّ أسماءه تعالى إمّا أن تدلّ علىٰ الذات فقط من غير اعتبار أمر، أو مع اعتبار أمر، ذلك الأمر إمّا إضافة ذهنية فقط، أو سلب فقط، أو إضافة وسلب. فالأقسام أربعة:
الأول: اسم الذات فقط
ما يدل علىٰ الذات فقط هو لفظ: «الله»، فإنّه اسم للذات الموصوفة بجميع الكمالات الربانيّة، المتفردة بالوجود الحقيقي، فإنّ كل موجود سواه غير مستحق للوجود بذاته، بل إنّما استفاده من الغير. ويقرب من هذا الاسم لفظ «الحقّ»، إذا اُريد به الذات من حيث هي واجبة الوجود، فإنّ الحقّ يراد به: دائم الثبوت، والواجب ثابت دائماً غير قابل للعدم والفناء، فهو حقّ، بل هو أحقّ من كلّ حقّ.
الثاني: أسماء الذات مع إضافة
ما يدلّ علىٰ الذات مع إضافة كـ «القادر»، فإنّه بالإضافة إلىٰ مقدور تعلقت به القدرة بالتأثير، و«العالم» فإنّه أيضاً اسم للذات، باعتبار انكشاف الأشياء لها، و«الخالق» فإنه اسم للذات باعتبار تقدير الأشياء، و «البارئ» فإنّه اسم للذات باعتبار اختراعها وإيجادها، و«المصوّر» باعتبار أنّه مرتّب صور المخترعات أحسن ترتيب، و «الكريم» فإنّه اسم للذات باعتبار إعطاء السؤالا، والعفو عن السيئات.
و«العليّ» اسم للذات باعتبار أنّه فوق سائر الذوات، و«العظيم» فإنّه اسم للذات
باعتبار تجاوزها حدّ الإدراكات الحسّية والعقليّة، و«الأول» باعتبار سبقه علىٰ الموجودات، و«الآخر» باعتبار صيرورة الموجودات إليه، و«الظاهر» هو اسم للذات باعتبار دلالة العقل علىٰ وجودها دلالة بيّنة واضحة، و«الباطن» فإنّه اسم بالإضافة إلىٰ عدم إدراك الحسّ والوهم، إلىٰ غير ذلك من الأسماء.
الثالث أسماء الذات باعتبار سلب الغير عنه
ما يدلّ علىٰ الذات باعتبار سلب الغير عنه، كـ «الواحد» باعتبار سلب النظير والشريك، و«الفرد» باعتبار سلب القسمة والبعدية، و«الغني» باعتبار سلب الحاجة، و«القديم» باعتبار سلب العدم، و«السّلام» باعتبار سلب العيوب والنقائص، و«القدّوس» باعتبار سلب ما يخطر بالبال عنه، إلىٰ غير ذلك.
الرابع أسماء الذات مع الإضافة والسّلب
باعتبار الإضافة والسلب معاً، كـ «الحيّ»، فإنّه المُدرك الفعّال الذي لا تلحقه الآفات، و«الواسع» باعتبار سعة علمه وعدم فوت شيء منه، و «العزيز» وهو الذي لا نظير له وهو مما يصعب إدراكه والوصول إليه، و «الرحيم» وهو اسم للذات باعتبار شمول رحمته لخلقه وعنايته بهم، وإرادته لهم الخيرات، إلىٰ غير ذلك» (3) انتهى.
تحقيق معنى الاسم:
التحقيق الأحق بالذكر في تبيين هذا المقام ما حقّقه الحكماء والعرفاء، فإنّ الاسم عندهم حقيقة الوجود ملحوظة بتعيّن من التعينات الكماليّة من صفاته تعالى، أو باعتبار تجلِّ خاص من التجليات الإلهية.
فالوجود الحقيقي مأخوذ بتعيّن كونه ما به الانكشاف لذاته ولغيره اسم «العليم»،
وبتعيّن كونه خيراً محضاً وعشقاً خالصاً اسم «المريد».
وملحوظاً بتعيّن الظاهر بالذات والمظهرية للغير اسم «النور»، وبتعيّن الفاضية الذاتية للنورية عن علم ومشيّئة اسم «القدير».
وبتعيّن الإدراكية الفعّالية اسم «الحي»، وبتعيّن الإعراب عمّا في الضمير المكنون الغيبي اسم «المتكلّم»، وهكذا.
وكذا مأخوذ بتجلٍّ خاصّ علىٰ ماهيّة خاصّة، بحيث يكون كالحصّة التي هي الكلّي المضاف إلىٰ خصوصيّة، بكون الإضافة بما هي إضافة ـ وعلى سبيل التقييد لا علىٰ سبيل كونها قيداً ـ داخلة، والمضاف إليه خارجاً، لكن هذه بحسب المفهوم، والتجلي بحسب الوجود اسم خاصّ.
نقل كلام المحقّق السبزواري:
عند هذا قال صدر المتألّهين السبزواريّ (قدّس سرّه): «فنفس الوجود الذي لم يلحظ معه تعيّنٌ ما، بل نحو اللاب تعيّن هو المسمّى، والوجود بشرط التعيّن هو الاسم، ونفس التعيّن هو الصفة، والمأخوذ بجميع التعيّنات الكمالية اللائقة به المستتبع للوازمها من الأعيان الثابتة الموجودة بوجود الأسماء ـ كالأسماء بوجود المسمّى ـ هو مقام الأسماء والصفات، الذي يُقال له في عرف العرفاء: المرتبة الواحدية، كما يقال للموجود الذي هو اللاتعيّن البحت: المرتبة الأحديّة.
والمراد من اللاتعيّن: عدم ملاحظة التعيّن الوصفي، وأمّا بحسب الهويّة والوجود فهو عين التشخّص والتعيّن والمتشخص بذاته والمتعيّن بنفسه، وهذه الألفاظ ومفاهيمها، مثل الحيّ العليم المريد القدير وغيرها، أسماء الأسماء» (4) انتهى كلامه، رفع مقامه.
قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180] قيل: هي: «الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدّوس، الخالق، البارئ، المصوّر...» إلىٰ تمام ثلاثمائة وستّين اسماً، كما في المجمع (5).
وفيه أيضاً قال الشيخ أبو علي _قدس سره): «(وَلِلَّـهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ) التي هي أحسن الأسماء؛ لأنّها تتضمن معاني حسنة، بعضها يرجع إلىٰ صفات ذاته، كالعالم والقادر والحيّ والإله، وبعضها يرجع إلىٰ صفات فعله، كالخالق والرازق والبارئ والمصوّر، وبعضها يفيد التمجيد والتقديس، كالقدّوس والغنيّ والواحد» (6) انتهى.
وعن الصادق (عليه السلام): (إنّ الله تعالى خلق اسماً بالحروف غير متصوّت، وباللفظ غير مُنَطق، وبالشخص غير مجسّد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفيّ عنه الأقطار، مبعّد عنه الحدود، محجوب عنه حسّ كلّ متوهّم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامّة علىٰ أربعة أجزاء معاً، ليس شيء منها قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحداً، وهو الاسم المكنون المخزون، فهذه الأسماء التي ظهرت، فالظاهر هو الله تبارك وتعالى، وسخّر لكلّ اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، فذلك اثنا عشر ركناً، ثم خلق لكلّ ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها، فهو الرحمن، الرحيم، الملك، القدّوس، الخالق، البارئ، المصوّر، الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نومٌ، العليم، الخبير، السميع، البصير، الحكيم، العزيز، الجبّار، المتكبّر، العلي، العظيم، المقتدر، القادر، السّلام، المؤمن، المهيمن، البارئ، المنشئ، البديع، الرفيع، الجليل، الكريم، الرزّاق (7)، المُحيي، المميت، الباعثُ، الوارث.
فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنىٰ، حتّىٰ تتم ثلاثمائة وستّون اسماً، فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة، وهذه الأسماء الثلاثة أركان، وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة، وذلك قول الله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110]) (8).
نقل كلام المحقّق السبزواري في شرح الحديث المذكور:
أقول: قد ذكر هذا الحديث الشريف صدر المتألّهين (قدس سره)، مشروحاً في «شرح الأسماء»، عند شرح الاسم الشريف: (يا مَن جعل في السماء بروجاً) (9)، ونقل كلام الفاضل المازندرانيّ الشارح لأصول الكافي ـ عليه الرحمة ـ وزُيّفَ بعض ما قال في شرح هذا الحديث. فالأولى والأنسب أن ننقل كلامه الشريف، وما حقّقه وما زُيّف من كلام الشارح، توشيحاً لهذا الشرح، ولا بأس بالإطالة والإطناب، إذ المقام مقام التفصيل والفحص في تحقيق أسمائه تعالى جليل جميل.
فقال (قدس سره): «قوله (عليه السلام): (إنّ الله تبارك وتعالى خلق اسماً ...) قال الفاضل المازندراني (10) الشارح لأصول الكافي ـ عليه الرحمة ـ: قيل: هو (الله)، وقيل: ـ هو اسم دالّ علىٰ صفات ذاته جميعاً. وكأن هذا القائل وافق الأوّل؛ لأنّ الاسم الدال علىٰ صفاته جميعاً هو «الله» عند المحقّقين، ويردّ عليهما أنّ «الله» من توابع هذا الاسم المخلوق أولاً، كما يدلّ عليه هذا الحديث.
ويحتمل أن يُراد بهذا الاسم اسم دالّ علىٰ مجرّد ذاته تعالى، من غير ملاحظة صفة من الصفات معه، وكأنّه «هو». ويؤيّده ما ذكره بعض المحقّقين من الصوفيّة من أنّ «هو» أشرف أسمائه تعالى، وأنّ (يا هو) أشرف الأذكار، لأنّ «هو» إشارة إلىٰ ذاته من حيث هو هو، وغيره من الأسماء يعتبر معه صفات ومفهومات قد تكون حجباً بينه وبين العبد.
وأيضاً إذا قلت: (هو الله الرحمن الرحيم الغفور الحليم)، كان «هو» بمنزلة الذات، وغيره من الأسماء بمنزلة الصفات، والذات أشرف من الصفات، فهو أشرف الأسماء.
ويحتمل أن يُراد به: (العليّ العظيم)، لدلالة الحديث الآتي عليه، حيث قال (عليه السلام): (فأوّل ما اختار لنفسه: العليّ العظيم). إلّا إنّ ذكره في أسماء الأركان ينافي هذا الاحتمال، ولا يستقيم إلّا بتكلّف، وهو أنّ مزج الأصل بالفرع للإشعار بالارتباط وبكمال الملائمة بينهما» (11) انتهى.
قال (قدس سره): «وفيه مؤاخذة؛ لأنّه ينبغي أن يُقال: ذلك الاسم مجموع: (هو الله الرحمن الرحيم)، أو مجموع: (هو الله العليّ العظيم)، لا أنّه «هو» وحده مثلاً، لقوله عليهالسلام (فجعله ...) إلىٰ آخره.
قوله (عليه السلام): (بالحروف غير متصوّت)، جعله هذا الشّارح (12) حالاً من فاعل (خلق)، أي خلقه والحال أنّه تعالى لم يصوّت بالحروف، ولم يخرج منه حرف وصوت، ولم ينطق بلفظ؛ لتنزّه قدسه عن ذلك، ولا يخفى أنَّ جعل هذا وما بعده ـ إلىٰ قوله (عليه السلام): (فجعله كلمة تامّة) ـ صفة له تعالى، فيه بعدٌ غاية البُعد، ولا سيّما التنزيه عن الجسميّة والكيفيّة والكميّة وغيرها ليس فيه كثير مناسبة لخلق ذلك الاسم، ولا خصوصية له به، بل الـ (متصوّت) والـ (منطق) بصيغة المفعول، والكلّ صفة الاسم، علىٰ ما سنذكره.
وقوله (عليه السلام): (مستتر غير مستور) أي مُستتر عن الحواس، غير مستور عن القلوب، أو معناه مستتر عن فرط الظهور.
قوله (عليه السلام): (علىٰ أربعة أجزاء معاً) قال الشارح (13): أي علىٰ أربعة أسماء باشتقاقها وانتزاعها منه، وهي غير مرتبة بعضها علىٰ بعض، كترتّب (الخالق) و(الرازق) علىٰ (العالم) و (القادر)، وعلى ما نذكر فالمقصود نفي الترتّب المكاني.
وقوله (عليه السلام): (وحجب واحداً منها)، أي لا يعلمه إلّا هو، حتّى الأنبياء (عليهم السلام)، فإنّه قد استأثر علمه لنفسه.
قوله (عليه السلام): (فهذه الأسماء التي ظهرت، فالظاهر هو الله تبارك وتعالى).
قال الشارح (14): (أي الظّاهر البالغ إلىٰ غاية الظهور، وكماله من بينها هو الله تعالى، ويؤيّده أنّه يضاف غيره إليه فيعرف به، فيقال: (الرحمن) اسم (الله)، ولا يقال: (الله) اسم (الرحمن)، وليس المراد أنّ المتّصف بأصل الظّهور هو (الله)؛ لأنَّ غيره أيضاً متّصف بالظهور، كما قال (عليه السلام): (وأظهر منها ثلاثة). وهذا صريح بأنَّ أحد هذه الثلاثة الظاهرة هو (الله). وأمّا الآخران فلم ينقلهما علىٰ الخصوص.
ويحتمل أن يُراد بهما (الرحمن الرحيم)، ويؤيّده آخر الحديث، واقترانهما مع (الله) في التسمية، ورجوع سائر الأسماء الحسنىٰ إلىٰ هذه الثلاثة، عند التأمّل.
ثمّ قال: إلّا إنّ عُدّ (الرحمن الرحيم) في جملة ما يتفرّع علىٰ الأركان ينافي هذا الاحتمال، ولا يستقيم إلّا بتكلّف مذكور.
ونسب إلىٰ بعض الأفاضل: أنّه يفهم من لفظ (تبارك): جواد، ومن لفظ: (تعالى) أحد.
قوله (عليه السلام): (أربعة أركان)، قال الشارح (15): اعتبار الأركان إمّا على سبيل التخييل والتمثيل، أو علىٰ سبيل التحقيق باعتبار حروف هذه الأسماء، فإنّ الحروف المكتوبة في كلّ واحد من الأسماء المذكورة أربعة.
ويحتمل أن يراد بالأركان كلمات تامّة مشتقّة من تلك الكلمات الثّلاث ومن حروفها، وإن لم نعلمها بعينها.
قوله (عليه السلام): (وذلك قول الله تعالى: (قُلِ ادْعُوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَـٰنَ) ).
قال الشارح (16): إنّما لم يذكر الثالث لقصد الاختصار، أو لأنّه أراد بالرحمن: المتّصف بالرحمة المطلقة الشاملة للرحمة الدنيوية والأخروية» (17).
قال (قدّس سره): «أقول: قد علمت حقيقة الاسم، وأنّ هذه الألفاظ أسماء الأسماء، فالمراد ـ وهم (عليه السلام) أعلم بمرادهم بذلك الاسم ـ: الوجود المطلق المنبسط، الذي هو تجلّيه وصنعه ورحمته الواسعة الفعلية، وجمله أربعة عبارة عن تجلّيه في الجبروت والملكوت والناسوت، ونفس ذلك التّجلي ساقط الإضافة عنها.
وبعبارة أخرى: أصلها المحفوظ، وسنخها الباقي، وروحها الكامن. ومعلوم أنّه بهذا الوجه مكنون عنده، فالخلق المفتاق إليها شيئيات ماهيّاتها، والأسماء الثلاثة هي التجلّيات عليها؛ إذ قد مرّ أنّه كما أنّ الوجود باعتبار تعيّن كمالي اسم من الأسماء، كذلك باعتبار تجلّ فعلي اسم أيضاً.
وإن كنت من المتفطّنين لحقيقة الخلق والإيجاد، وأنّه اختفاء نور الحق تعالى في حجب أسمائه، وفي حجب صور أسمائه، وأنَّ مدّة اختفاء النور دورة الخلق، كما أنّ مدّة ظهور نوره واستتار حجبه دورة الحق وإفنائهم {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} [المعارج: 4]، لوسع لك تجويز أن يكون ذلك الاسم أعمّ من الرحمة الصفية والرحمة الفعلية.
والمكنون منه هو التجلّي اللاهوتيّ، أعني: التجلّي في أسمائه وصفاته في المرتبة الواحدية، والثلاثة الظاهرة ـ التجلّيات الثلاثة المذكورة ـ والاكتنان هنا أشدّ؛ لأنّه إذا كان الرحمة الفعلية ساقطة الإضافة من صقع الذات، كان الرحمة الصفية أوغل في ذلك؛ لأنّ الصفة أقرب من الفعل.
وقوله (عليه السلام): (فالظاهر هو الله تبارك وتعالى) معناه: أنّه لمّا كان الاسم عنواناً للمسمى وآلة للحاظه، فالأسماء الثلاثة ظهورات المسمّى، فهو الظاهر؛ لأنَّ معنى (الظّاهر) ذات له الظهور، فالذات التي هو (الله)، له الظهورات، فهو الظاهر بالأسماء.
أو المراد: أنّ الأسماء الثلاثة ظهورات الاسم المكنون المستأثر لنفسه، الذي هو عنوان لذاته تعالى عند ذاته، لكنّه معنون بالنسبة إلىٰ الثلاثة. والدليل علىٰ هذا المراد أنَّ (الله) اسم واقع علىٰ الحضرة الواحدية كاللاهوت، فإنّ معناه: الذات المستجمع لجميع الصفات والكمالات، وتلك الحضرة أيضاً مجمع الأسماء والصفات، ولذا عبّر في حديث الأعرابي (18) عن النفس اللاهوتية بذات الله العليا.
والأركان الأربعة لكلّ واحد من هذه الأسماء عبارة عن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة المعنويات، أعني: حرارة العشق والابتهاج، وبرودة الطمأنينة والإيقان، ورطوبة القبول والإذعان، أو الإحاطة والسريان، ويبوسة التثبّت والاستقامة عند الملك المنّان، نظير ما قال بعض أهل الذوق كجابر بن حيّان: إنّ السماوات وما فيها من العناصر الأربعة، وحمل عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة المشيئة، المذكورة في نهج البلاغة. والصواب: الحمل علىٰ ما ذكرنا.
والغرض كلّ الغرض منه: تطبيق العالمين الظّاهر والباطن، بجعل ذلك الاسم كالنّير، والاثني عشر ركناً بروجه، والثلاثين اسماً درجات كلّ برج، حتّىٰ تتم ثلاثمائة وستون درجة، وهي تعيّنات الأسماء التي انطوت فيها، وهي مظهرها، فيكون بعدد درجات دورة الفلك الظاهر» (19).
ثمّ قال (قدس سره): «أو نقول: المراد بذلك الاسم: الغوث الأعظم الذي هو خاتمة كتاب الوجود، كما أنّ المعنى الأول الذي هو فاتحته وروحانيته، وهو ختم الكلّ والاسم الأعظم، وقال خلفاؤه: (نحن الأسماء الحسنىٰ) (20) فجعله أربعة أجزاء ثلاثة منها ظاهرة، هي: العقل والقلب والنفس، وواحد مستور، هو أصلها المحفوظ الذي لا يعلمها إلّا الله.
وهذه الثلاثة هي المشار إليها بقوله تعالى: {حم * عسق} [الشورى: 1، 2] أي حقّ لا باطل، «محمد» الذي هو العقل والنفس والقلب، أو (حم) أي التسعة والتسعون من الأسماء، هو: العقل والنفس والقلب من الإنسان الكامل، أو الثّمانية والأربعون من الصور التي هي مجالي شمس الحقيقة، هي: العقل والنفس والقلب، ثم الأركان الاثنا عشر والدرجات الثلاثمائة والستون كما سبق.
وكان بروج نوره الواحد التي هي خلفاؤه في هذا العالم أيضاً اثني عشر، كلّ واحد منها مظهر ثلاثين اسماً باعتبار من الأسماء المحيطة.
ثمّ المقصود من ذكر الأسماء: إمّا تعداد علىٰ سبيل التمثيل فلا كلام، وإمّا تعيين ثلاثين، فيكون بعضها من الأسماء المركّبة، كـ (الرحمن الرحيم) و (العليّ العظيم) مثلاً، فإنَّ (العلي) ـ مثلاً ـ مفرداً اسم من أسمائه وله خاصيّة علی حدة، وكذا لـ (العظيم)، ومركّباً اسم وله خاصّية أخرى، ومن المركّبة: (البارئ المنشئ). فلا تكرار من الناسخ، كما زعمه الشارح المذكور» (21) انتهى كلامه الشريف.
الأركان: جمع «ركن»، وهو جانب الشيء.
قول السائل: (ملأت أركانَ كلِّ شيء) أي أطرافه وجوانبه.
ثم اعلم أنّه كما قال العرفاء الشامخون: إنَّ كل نوع من الأنواع تحت اسم من أسماء الله تعالى، وذلك النوع مظهر ذلك الاسم، كما أنّ الإنسان مظهر اسم (الله)، والملك مظهر (السبّوح) و(القدّوس)، والفلك مظهر اسم (الرفيع الدائم)، والحيوان مظهر (السميع والبصير)، والأرض مظهر (الخافض)، والهواء مظهر (المروّح)، والماء مظهر (المحيي)، والنار مظهر (القهّار) وهكذا.
وعلمت ممّا سبق أنّ الاسم عبارة عن المسمّى مأخوذاً بتعيّن من التعيّنات الكماليّة، فكما أنّ ماء الحياة الذي هو الوجود المطلق سارية في جميع الأودية، ونفذت في أعماق الأشياء، كذلك توابع الوجود التي تدور رحاها علىٰ قطب الوجود سارية في جميع الموجودات، ولكن في كلٍّ بحسبه وقدره، علىٰ ما اقتضته الحكمة الإلهية.
ثمّ إنَّ من الموجودات ما له أربعة أركان:
منها: أركان عرش علم الله تعالى من العناية، والقلم، والقضاء، والقدر.
وأركان عرشه العيني من الركن الأبيض، والركن الأصفر، والأخضر، والأحمر.
ومنها: أركان عرش قلوب المؤمنين من العقل بالقوّة، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد.
ومنها: أركان علم الإنسان من التعقّل والتوهّم والتخيّل والتحسّس، وأركان بدنه من الماء والتراب والهواء والنار، هذه وسائطه، أو مركباته من الدم والبلغم والصفراء السوداء.
وأركان بيت الله المعنوي أيضاً، التي هي: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ويقال لها: حملة العرش.
وأركان بيته الظاهري من الركن اليمانيّ، والحجازيّ، والشاميّ، والعراقيّ، وغيرها ممّا لا نطيل الكلام بذكرها، فجميعها مالية (22) من صفاته وأسمائه تعالى...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



|
|
|
|
هل يمكن للدماغ البشري التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم؟
|
|
|
|
|
|
|
علماء: طول الأيام على الأرض يزداد بسبب النواة الداخلية
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يشرك طلبة الدورات الصيفية بمحفلٍ قرآني في محافظة بابل
|
|
|